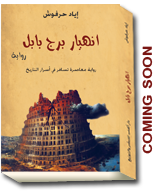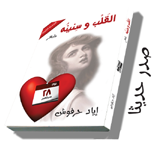- بوفاة رابع الراشدين انتهت الدولة الإسلامية التي استحقت هذا الاسم (عدا حقبة خامسهم)، والتي كان محورها الكفاية والعدل، فلا محل اليوم لتعبير "دولة إسلامية" الذي يصفون به مصر، فهي دولة بها أغلبية مسلمة وحسب. فهي دولة صنعتها حقائق الجغرافيا والتاريخ ولم تصنعها العقيدة كدولة المدينة المنورة قديما
- صار لكل دولة جيشها الوطني الذي يضم كل أبنائها على اختلاف مللهم، ومهمته محدودة في حماية الدولة ومصالحها، فلا محل اليوم لحديث عن ذميين وجزية وما إلى ذلك من تجديف
7.1.11
حسان والحويني وأهل الذمة
23.11.10
الآخرون
- البروتستانت: وهو اسم يطلقه الكاثوليك والأرثوذكس على المذاهب والكنائس الغير أصولية (غير كاثوليكية أو أرثوذكسية)، بينما الاسم الذي يطلقه معتنقو تلك المذاهب على أنفسهم هو الإنجيليون، بداية من تأسيس "مارتن لوثر" للكنيسة الإنجيلية الألمانية، لتأسيس كنيسة بريطانيا الإنجيلية ونهاية بالكالفينية، والإنجيليون هو الاسم الأدق لأنه يعبر عن اعتماد المذهب على الأصول الإنجيلية للعقيدة بعيدا عن الفكر الديني لبولس الرسول والقديس "بطرس"، لكن يبدو أن الكاثوليك فضلوا اسم البروتستانت، المشتق من لفظة المعترضين أو المعارضين اللاتينية، ففيه وصف ضمني لتلك المذاهب بأنها انشقاق مستحدث عن الكاثوليكية، فيكون بمثابة التشكيك الضمني في أصالتها
- النواصب: هو الاسم الذي يطلقه متطرفو الشيعة على الطائفة التي تطلق على نفسها اسم أهل السنة والجماعة، وذلك لادعائهم أن هؤلاء ناصبوا آل البيت العداء، وهذا غير صحيح لأن المسلمين السنة اليوم ليسوا امتدادا لمعسكر معاوية ويزيد بحال من الأحوال، بل منهم من لا يعترف بشرعية حكم الأمويين
- الروافض: هو الاسم الذي يطلقه متطرفو السنة بدورهم على كافة المذاهب التي تسمي نفسها شيعية، نسبة لشيعة علي، وسبب الاسم هو ادعاء أن الشيعة هم من "رفض" الانضواء تحت لواء الجماعة في عام الجماعة، وهذا بدوره ليس صحيحا، لأن عام الجماعة أو ما سمي تاريخيا بهذا الاسم وهم كبير
- الخوارج: هو الاسم الذي أطلق على الخارجين عن إمرة الإمام علي بعد موقعة الجمل والتحكيم، بينما تعود المنتمون للمذهب أن يسموا أنفسهم جماعة المؤمنين، وكأنهم وحدهم كذلك، أو الشراة، الذين اشتروا الآخرة بالدنيا، ونسبوا كذلك لكبرائهم فعرفت منهم جماعات هي الأزارقة والصفرية، ومنهم اليوم فرقة الإباضية
- المعتزلة: جماعة فكرية امتازت بفكر وفلسفة مميزة وإن لم تمثل طائفة دينية مستقلة، سماهم خصومهم من الأشاعرة خاصة باسم المعتزلة لاعتزالهم مجلس العلم في حلقة الحسن البصري، بينما يسمون هم أنفسهم أهل العدل والتوحيد
- الدروز: وهم طائفة مستقلة يخلط البعض بينهم وبين الطوائف الشيعية، ويسميهم خصومهم الدروز نسبة لنشتكين الدرزي، بينما يسمون هم أنفسهم الموحدين أو أهل الجبل الموحدين
- الصابئة: أحد الأديان الموجودة في مناطق محدودة من العالم أهمها العراق، وهم غير الصابئة المذكورين في القرآن الكريم، وهذا هو الاسم الذي يسميهم به خصومهم بينما يسمون هم أنفسهم المندائيين
- الأقباط: جمع قبطي، ومعناها مصري (هيكوبتاح في المصرية القديمة بمعنى أفق بتاح، تطورت إلى هيكوبتاس في العصر الروماني، ثم كوبتاس، والتي صحفت بالعربية إلى قبطي) ويطلقها المسلمون المصريون على المسيحيين المصريين خطأ، فمسمى الأقباط الأرثوذكس معناه الأرثوذكس المصريين مثل السوريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس
- السلفيون: وهو الاسم الذي تطلقه الجماعات الأصولية على نفسها، بادعاء تقليد السلف الصالح، وهو غير صحيح لأن كل طائفة تظن نفسها مقلدة للسلف، والأدق تسميتهم بالوهابيين نسبة للمؤسس المعاصر، أو التيميين نسبة لابن تيمية، ولو أردنا ردهم لما قبل ابن تيمية يمكن تسميتهم بالحنابلة وان كان هذا غير دقيق لأنه ليس كل الحنابلة تيميون
4.10.10
كار الرئاسة
- الاقتصاد أخطر من أن يترك للاقتصاديين، هكذا قال أحد رؤساء الولايات المتحدة (أظنه روزفلت) وهو محق بالطبع، لهذا يتعين على رأس الدولة أن يكون ملما بالاقتصاد الدولي ومتابعا جيدا لتطوراته، ولديه بصورة عامة الحس الاقتصادي الذي يمكنه من نقد الخطط الاقتصادية التي يقترحها الوزراء والخبراء في إدارته
- الممارسة السياسية في مصر بما يكفي، أو على أقل تقدير المتابعة اللصيقة للحياة السياسية فيها، حتى تكون لديه خبرة تعصمه من استخدامه بواسطة بعض القوى السياسية المصرية كما حدث مع الرئيس محمد نجيب قديما وكما حدث مع البرادعي أمس القريب، خدع الوفديون والإخوان الرئيس نجيب قديما وأوهموه أن الشعب والجماهير معه ثم تركوه في أزمة مارس عاريا، وخدع الإخوان البرادعي مؤخرا وأوهموه بتحالف انهار مع صفقتهم الانتخابية مع النظام
- امتلاك رؤية للسياسة الدولية وعلاقات القوى وتحرك موازينها على المستوى الدولي والإقليمي، وبصفة خاصة لتحركات أربعة قوى على الساحة العالمية اليوم، اليمين الآنجلو-أمريكي المهيمن على منظومة العالم الجديد، ويسار الوسط السائد في الاتحاد الأوروبي ومحاولاته الدائمة لحفظ التوازن بعد غياب الاتحاد السوفيتي، قوى اليسار التحرري في أمريكا اللاتينية وأخيرا الصين الماوية والشرق الأقصى
- امتلاك رؤية للسياسة الإقليمية وانعكاس الصراع العالمي عليها، بوجود كتل متحالفة مع اليمين العالمي ممثلة في السعودية والإمارات العربية والكويت وقطر، وقوى متحالفة مع اليسار التحرري ممثلة في إيران وسوريا
- الإلمام الكامل بتاريخ مصر، فضلا عن الإلمام الوافي بتاريخ المنطقة والإحاطة المعقولة بتاريخ العالم الحديث والمعاصر
- القدرة على تبني خطاب سياسي قيمي وأخلاقي يوازن ويحجم أثر أربعين عاما متصلة من الخطاب السياسي الانتهازي الذي أورث تدهورا عاما في منظومة القيم في المجتمع والسلوكيات على مستوى الشارع، وأن يمكنه تاريخه من عدم المزايدة عليه عند تبني هذا الخطاب القيمي
- مدعوم بتيار شعبي معقول بخلفية أيديولوجية أو وطنية أو حتى فئوية توفر له غطاء سياسيا في حالة تطبيق السياسات الجريئة المطلوبة منه ليعود بالدولة للانحياز الواجب عليها مع المهمشين والفئات الأكثر حاجة لرعاية مصالحها الأساسية، نظرا لردود الفعل الحتمية من جانب رأس المال الانتهازي الذي سيحاول الالتفاف شعبيا على الرئيس حال تطبيق تلك السياسات
- الموهبة الإدارية والملكات القيادية التي تمكنه من اختيار الإدارة التي ستعينه على تنفيذ برنامجه وإدارة تلك المجموعة على مستوى القمة بنجاح خلال فترة رئاسته
لو حاولنا تطبيق القائمة السابقة على المرشحين الشعبيين ممن يحول الدستور بمواده الحالية بينهم وبين الترشيح لوجدنا ما يلي
- حمدين صباحي لديه قصور نوعي في النقاط 1، 3 و 8 من القائمة، أما الخبرة السياسية فهو أكثرهم خبرة وممارسة لواقع السياسة المصرية وفصائلها، وكذلك معارفه التاريخية مميزة، ومتابعته للسياسة الإقليمية ممتازة، وهو قادر على تبني خطاب قيمي ومميز فيه بالفعل، وكذلك يملك دعما في الشارع من التيارات الجماهيرية والنخب الناصرية فضلا عن دعم نوعي من تيارات اليسار الكامنة
- محمد البرادعي لديه قصور نوعي في النقاط 1 ، 5 و7، والأهم قصور كلي في النقطة 2 من القائمة السابقة، وله في المقابل دراية واسعة بالسياسة الدولية وإلمام معقول بالسياسة الإقليمية، وهو قادر على تبني خطاب قيمي وتاريخه يمكنه من ذلك، ثم لديه الخبرات التنظيمية والإدارية على أرفع مستوى، فهو مدير ناجح بحكم تجربته المهنية ولو لم يكن زعيما
- أيمن نور لديه قصور نوعي في النقاط 1، 4 وقصور كلي في النقاط 3، 5 و8 من نفس القائمة، ونور يأتي بعد حمدين مباشرة في الخبرة والممارسة السياسية لفترات معقولة، وهو قادر كذلك على تبني خطاب قيمي وقادر على اكتساب التعاطف الجماهيري بطريقة مختلفة عن طريقة حمدين والبرادعي ولكنها في النهاية ناجحة، وكذلك لديه دعم نوعي جماهيريا على الأقل من شباب الغد وكنتيجة لتجربته السابقة في 2005م
لو طبقنا نفس النقاط على المرشحين المحتملين من جانب الحزب الوطني، والممهد لهما الوصول للحكم بالتمديد للأب أو التوريث للابن فسوف نجد ما يلي
- مبارك الأب لديه بعد كل هذه السنوات قصور نوعي في النقاط 1و8، وقصور كلي في النقاط 3، 4، 5، 6 و7، وقد يقول قائل كيف لديه كل هذا القصور وقد حكم بالفعل لحوالي ثلاثين عاما؟ والرد ببساطة هو ما آلت إليه أوضاع مصر الراهنة
- جمال مبارك لديه قصور نوعي في النقطة 1 وقصور كلي في النقاط 2، 3، 4، 5، 6، 7 و8 من القائمة، أو بمعنى أدق قصور كامل في المؤهلات اللازمة للرئاسة
18.9.10
في عقلنا خلل
- الاستخدام الأروع للنت هو المكتبات الإلكترونية العملاقة، وبصفة خاصة القابلة للبحث في مراجعها بمحركات بحث خاصة، مكتبة الكونجرس، مشروع جوتنبرج لحفظ التراث الفكري الإنساني، مواقع تفسير القرآن، كلها مصادر عبقرية ولا شك لهذا الغرض
- الانترنت وسيلة ممتازة للوصول لكتاب الكتروني أو بحث وقراءته مجانا، حتى لو كنت مثلي من مدمني الكتب المطبوعة، والتي مازالت لها السيادة عالميا رغم تكلفتها، لكنك أحيانا لن تجد كتابا ما بسهولة في المكتبات وقد تجده أونلاين، لكن عليك أن تحفظ كل ما تقرأ في ملفات على جهازك ولا تتصفحه أونلاين فقط لتتمكن من العودة إليه حين تريد، الحفظ في المفضلة لا يكفي لأنك قد لا تجده متاحا حين تريده بعد عام من الآن أو بعد إعادة تحميل الويندوز
- المنتديات وساحات الحوار والفيسبوك ليست مصادرا لمعلومة تاريخية ولا علمية بحد ذاتها، فلو لفتت نظرك فيها معلومة عليك باقتفاء أثرها والبحث عنها حتى توثقها بمرجعية محترمة يمكنك أن تنسبها إليها، وإلا فلا تعتد بها ولا ترددها لأنك قد تنشر بهذا معلومة مغلوطة وأحيانا مغرضة
- ويكيبيديا بكل اللغات مصدر معقول للمعلومة ولكنها ليست مرجعا بذاتها رغم الضوابط، لأنها موسوعة يحررها الجماهير مثلي ومثلك وفقا لمعايير محددة، فهي مجال جيد للتصفح والمطالعة ولكن ليس للتوثيق ولا للبحث الموضوعي
- عليك التعرف على هوية وتوجهات كل موقع ترتاده بحثا عن معلومة، حتى تتأكد من نزاهة وموضوعية المعلومة محل البحث
13.7.10
جسر الكرامة-08
كانت شعبية ناصر في الشارع المصري، بل والعربي، منذ 1956م فصاعدا أكثر من كافية لاستمراره في الحكم، فلم يكن نموذج التنظيم السياسي الواحد الذي انتهجته الثورة هادفا لتثبيت الزعيم الراحل في موقع الرئاسة، لكن دافعه الجوهري كان تجنب مصير حكومة مصدق الوطنية، والتي أطاحت بها المؤامرة الآنجلو-أمريكية بيد معارضة إيرانية، وكان التقارب الزمني للتجربتين مبررا نفسيا لهذا الهاجس.
لكن ما نراه الآن، وما كان متعسرا رؤيته في مطلع الخمسينات، هو بعد الحالة الإيرانية عن الحالة المصرية، بحيث لا تجوز المقارنة بين الحالتين، وبحيث يصبح الخوف من ثورة مضادة في مصر هاجسا ينقصه التبرير الكافي. فما هي الفروق بين تجربة مصدق وتجربة ناصر؟
1. كان ناصر مؤيدا من المؤسسة العسكرية ولم يكن لمصدق نفس درجة التأييد من المؤسسة العسكرية الإيرانية.
2. مناطق النفوذ البترولي المقسمة بين القوى العظمي الدولية كانت ومازالت خطوطا حمراء، تقدم هذه القوى على أي فعل أو موقف لحمايتها، بعيدا عن أية معايير خلقية أو إنسانية. لهذا حاول اللوبي الآنجلو-أمريكي الرجعي الإطاحة بناصر لكنه لم يتفانى في هذا بنفس الدرجة التي أظهرها في حالة الدكتور مصدق.
3. وجود الشاه وسرعة تكليف رئيس وزراء جديد بعد الإطاحة بحكومة مصدق وسجنه وفرت غطاء شرعيا لم يكن متاحا في التجربة المصرية لو حاولت الإطاحة بناصر.
4. المحيط الإقليمي لإيران من دول الجوار لم يكن كثير الارتباط أو الاهتمام بنظام مصدق، وإن قدره كل أحرار العالم تقديرا سلبيا، أما في حالة ناصر، فعملية إطاحة به كانت كفيلة بغليان المنطقة العربية البترولية، خاصة في العراق والكويت، لهذا كانت محاولات المخابرات الأمريكية مع ناصر محاولات اغتيال سرية دائما ، وليست محاولات انقلابية.
ولهذا نقول أن الإحجام عن التعددية السياسية منذ 1956م فصاعدا كان قصورا يفتقر للتبرير الكافي
جسر الكرامة-07
نفهم أن تكون البلاد في عام 1952م بعد ما تردت إليه أوضاعها سياسيا واجتماعيا بحاجة ملحة لنظام ثوري لفترة مؤقتة، ينهض بحاجاتها الملحة تنمويا وإصلاحيا، أو دعنا نقول أنها بحاجة إلى حكومة فترة انتقالية، لمدة تتراوح بين العامين والخمسة أعوام، فهذا الشكل الانتقالي معهود في الظروف المشابهة عالميا، لكن القصور في ثورتنا المصرية نتج عن عاملين محوريين، وهما
1. عدم تحديد مدة زمنية قصيرة يصدر خلالها الدستور الدائم وتعود للحكم مدنيته المطلقة، ولا يمنع هذا من استمرار قائد الثورة في موقعه الرئاسي بانتخابات نزيهة، كان سينجح فيها ولا ريب بحكم شعبيته الهائلة في الشارع المصري، كذلك لا يمنع عودة الحكم للشكل المدني من استمرار الأكفاء من العناصر العسكرية في مواقعهم بعد استقالتهم من الجيش.
2. استمرار مجلس قيادة الثورة عسكريا صرفا، وكان الأولى والأقرب لكفاءة صناعة القرار ضم عناصر مدنية مشهود لها بالنزاهة والوطنية كأعضاء في المجلس لا كمستشارين
جسر الكرامة-06
هكذا كان لمحمد علي الفضل في أول مشروع حضاري لدولة مصرية في العصر الحديث، وإن كانت المؤامرة الأوروبية العثمانية قد قهرت حلمه وهو فوق سنام المجد، تماما كما كسرت القوى الآنجلو-أمريكية الصهيونية بتحالفها مع الأنظمة العربية الرجعية الحلم الناصري وهو في أوج العنفوان. ولو كانت الدولة المصرية قد انكفأت داخل حدودها بعد انهيار الحلم الامبراطوري لمحمد علي، إلا أنها حافظت على استقلالها النوعي رغم التبعية الاسمية للباب العالي بقية عهد محمد علي ثم عهد ولديه إبراهيم باشا وسعيد باشا، ثم عهد حفيده الخديو إسماعيل، حتى ثار المصريون على عسف الخديو توفيق بقيادة القائمقام المصري أحمد عرابي، فاستغاث الخديو العلوي بالإنجليز، ليحتلوا مصر عام 1882م، تاركين تبعيتها اسميا للباب العالي حتى قامت الحرب العالمية الأولى عام 1914م، ففصل الإنجليز مصر عن الباب العالي وأعلنوا الحماية عليها.
وبرغم الاحتلال العسكري المباشر والهيمنة الإنجليزية الوقحة خلال الفترة ما بين 1882م و1952م، لم يحل بمصر ما يمكننا أن نطلق عليه عصر انحطاط جديد، لكنها دخلت عصرا انتقاليا هذه المرة، لتوافر سمات الحقبة الانتقالية التي فصلناها سابقا فيه
كانت مقاومة الإرادة المصرية للتبعية الأجنبية خلال تلك الحقبة هي الأروع في تاريخها كله برأينا، فقد كانت مقاومة لم تعرف الانقطاع إلا لتتصل من جديد، وكان هذا بفضل مسيرة التنوير التي أطلقها محمد علي باشا وأسهم فيها حفيده إسماعيل إسهاما ملموسا، فبفضل العلم أدرك المصريون قيمة الحرية واستقلال الإرادة الوطنية، وأن الحرية ليست جوهر كرامة الفرد والمجتمع فحسب، لكنها كذلك لقمة الخبز على مائدة كل أسرة، والماء النظيف في كل بيت، والأمن على الأنفس والأموال والأعراض في كل حي، لهذا كانت بسالتهم واتصال نضالهم ملحمة لعلها الأروع بطول تاريخهم، والأكثر فاعلية، وذلك رغم الحقبة الخاملة قرب نهاية تلك الفترة الانتقالية. وكانت أهم مراحل النضال الوطني هي:
1. واجه الاحتلال أول ما واجه جيش مصر الوطني في التل الكبير بقيادة عرابي، وهزم الجيش المصري بعد تضحيات جليلة قدمها رجاله.
2. مات توفيق ليتولى الحكم بعده أكبر أولاده الذكور وهو عباس حلمي الثاني، وكان الخديو عباس أو "أفندينا عباس" كما سماه المصريون حبا وتكريما وطنيا بما يكفي لينحاز للشعب في مناوئة سلطة الاحتلال، فكان شوكة في حلق المستعمر ما بين 1892م وقيام الحرب العالمية الأولى، حين عزله الإنجليز وولوا مكانه خائنا جديدا من الأسرة العلوية بعد توفيق هو السلطان حسين كامل. وأعلنت الحماية رسميا. وقد تزامن حكم عباس حلمي مع مقاومة الزعيم مصطفى كامل ثم محمد فريد.
3. بانتهاء الحرب العالمية ظهر دور الوفد المصري بقيادة الزعيم سعد زغلول في المقاومة السلمية للاحتلال، واندلعت ثورة 1919م في الأحداث الشهيرة التي كانت من أروع صفحات النضال الوطني، حتى أعلن الاستقلال الشكلي عام 1922م بتولية فؤاد الأول ملكا على مصر.
4. منذ 1928 وحتى 1952 دخلت مصر حقبة تبادل الوفد مع وزارات الأقليات السلطة فيها، حتى شكل النحاس الذي تزعم الوفد خلفا لسعد زغلول خمسة وزارات في تلك الفترة التي لم تتجاوز الأربعة عشر عاما، وفقد النحاس الإجماع الشعبي بعد معاهدة 1936م التي حالف فيها الإنجليز في زمن الحرب ضد النازي وإن كان دافعه لعقدها وطنيا وهو خروج الإنجليز من القاهرة للقناة. وفقد المزيد من التعاطف الشعبي بعد خروج مكرم عبيد باشا أحد أقطاب الوفد من الحزب ونشره الكتاب الأسود الذي ألقى ظلالا كثيفة على الذمة المالية للسيدة زينب الوكيل زوجة النحاس وعلى دور فؤاد سراج الدين الذي بدأ يهمش دور مصطفى النحاس.
5. بعد تصاعد الأحداث وحريق القاهرة عام 1952م، وتأسيسا على تداعيات معاهدة 1936م وحرب فلسطين 1948م، قامت حركة الجيش في 23 يوليو 1952م، لتبدأ مسيرة الدولة المصرية الثانية، بعد دولة محمد علي باشا في تاريخنا الحديث والمعاصر.
11.7.10
جسر الكرامة-05
أما عن المعاناة الاقتصادية في مصر العثمانية فحدث ولا حرج، ويكفي أن عبارة أليمة تجدها مكررة في تاريخ الجبرتي كل بضعة صفحات، يقول فيها "وزادت الأسعار، وحل بالناس مالا يوصف، فتغيرت القلوب والطباع، وكثر الحسد والحقد، وعربدت أولاد الحرام وفقد الأمن، ورحلت الفلاحون عن بلادهم وانتشروا في المدينة بأولادهم وهم يصيحون من الجوع، وأكلوا ما كان يتساقط في الشوارع من قشور البطيخ وغيره، فلا يجد الزبال شيئا يكنسه، وأكلوا الحمير الميتة، ومات كثير من الفقراء من شدة الجوع وعز الدرهم والدينار في أيدي الناس"، فهل بعد هذا العناء عناء؟
سمات الانحطاط
بغض النظر عن أوهام بعض التيارات السياسية اليوم والتي تكثر الحديث عن مآسر الدولة السنية، والخلافة الإسلامية، وتمن علينا برفض السلطان عبد الحميد تمكين اليهود من وطن قومي بفلسطين، وتنسى أن تبرر لنا لماذا احتل هو وقومه فلسطين أساسا؟ وقد كانت مسلمة قبل أن يسمع أجداد عثمان طغرل اسم النبي عليه الصلاة والسلام! بغض النظر عن كل هذا، كانت مصر العثمانية هي عصر الانحطاط الرابع في تاريخنا، والذي رأينا معا في هذا الفصل من كتابنا أن عصور الانحطاط فيه اشتركت في سمات أهمها:
1. فقدان مصر لاستقلالها وحرية إرادتها الوطنية، سواء بالاحتلال الكلي أو الجزئي أو التبعية لغيرها، سواء صحب هذا تسيد بطانة أجنبية على أهم المواقع في الدولة والجيش أم لا.
2. استنزاف خيرات مصر بنهبها على يد الغزاة والمتعاونين معهم من المصريين، ومعاناة المصريين من ضغوط اقتصادية تراوحت بين الفقر والبؤس والمجاعة الحقيقية في بعض الأحيان.
3. انكفاء مصر داخل حدودها الجغرافية، واختفاء نفوذها من محيطها الاستراتيجي.
وختمت حلقات الانحطاط العثماني المتصلة بتزايد نفوذ المماليك مرة ثانية ممثلين في مناصب شيخ البلد وأمير الحج التي احتكروها، فقد استعان بهم الترك على قهر الانتفاضات المصرية التي أثارها الجوع والطغيان، كما استعانوا بهم في جباية الضرائب والمكوس، وقل عدد الحاميات العثمانية في مصر، وهمش دور الباشا العثماني وصار شكليا، حتى جاءت الحملة الفرنسية فلم يتصد لها البكوات المماليك ولا الباشا التركي. فاحتلت مصر وكان الاحتلال الفرنسي هو قاع الهوان العثماني المملوكي في مصر، ولم تخرج الحملة بغير المقاومة المتصلة في الأقاليم والصعيد فضلا عن ثورتي القاهرة، وبخروج الفرنسيين وثورة المصريين على خورشيد باشا العثماني وخلعه، وترشيح محمد علي باشا للباب العالي سلفا له، بدأت نهضة مصر الحديثة، وأول دولة مصرية مستقلة منذ عهد الفراعنة، مصرية وليست متمصرة.
جسر الكرامة-04
أشرت في كتابي "وجع الدماغ" للخلاف السفسطائي الدائر حول وصف دخول العرب لمصر في عهد الخلافة الراشدة، هل كان فتحا أم غزوا أم احتلالا؟ وفصلت رأيي بأنه كان الثلاثة معا، وهذا شأن كل حدث تاريخي، يعتمد وصفه على الموقع الذي تصفه منه، فقد كان في نظر العرب الفاتحين فتحا عظيما ثبت ركائز دولتهم الناشئة بثرواته وتراثه. وكان من وجهة نظر النسر الروماني المتعجرف غزوا بربريا من بدو الصحراء يقتطع أطراف الامبراطورية المقدسة، وكان من وجهة نظر المصريين احتلالا جديدا يحل محل القديم. وهذا ما سجله ساويرس بن المقفع ويوحنا النقيوسي في حولياتهم. فهل خرج المصريون مرحبين بالعرب الغزاة حقا؟ تلك أسطورة نسميها أسطورة السمن والعسل. وخطورتها تكمن في ترسيخ صمرة المصريين كشعب خنوع طوال الوقت ومنذ فجر تاريخه، حتى اليوم، وهي مقولة لم تختبر.
أكاذيب السمن والعسل
من يقرأ الفتح العربي في كتبنا المدرسية يتكون لديه شعور بالامتعاض من خنوع الشعب الطيب الذي رحب بالاحتلال العربي، ليخلصه من الروماني، كأن الاحتلال قدر لا فكاك منه، والحقيقة غير ذلك، فقد قاوم المصريون الفتح واستمرت بعض جيوب المقاومة مثل دمياط لعدة عقود، وتمردت الاسكندرية وساعد المصريون وفي طليعتهم بطريرك الكرازة المرقسية حملة رومانية بقيادة إيمانويل الخصي لاستردادها، لكن عمرا بن العاص تصدى للحملة وأجهضها، ثم عاقب السكندريون بجباية باهظة جعلت المصريون يتحدثون للمرة الأولى في أدبهم الشعبي عن "بيع عيالهم"، كناية عن شدة العوز.
كذلك ثار المصريون على الحكم الأموي أربعة ثورات في 725، 726، 739 و 750 ميلادية، وقهرت كل تلك الثورات بحمامات الدم والعنف المدمر. وكانت ثورات المصريين ضد الأمويين قبطية مسيحية في مجملها. ثم زادت الجباية أكثر وأكثر مع دولة البذخ العباسية، فثار المصريون جميعا، المسلم منهم يدا بيد مع المسيحي، واشتعلت ثورات عامي 828 و831م ضد الولاة العباسيين. حتى انتهى الاضمحلال الثالث الطويل باستقلال مصر للمرة الأولى على يد أحمد بن طولون، فكانت الدولة الطولونية أول الدول المتمصرة المستقل
الدول المتمصرة المستقلة
أبتسم متعجبا لقصور رؤية من يتحدث عن حركة الضباط الأحرار في يوليو وكأنها أول حركة سياسية استولت فيها المؤسسة العسكرية على مقدرات الحكم في مصر، فتجربة حكم العسكر متكررة في تاريخنا القديم والحديث بكثافة، ولو كان "حور-محب" أول قائد عسكري يستولي على حكم مصر في تاريخها الفرعوني، فقد شهدت الخلافة العباسية قائدا عسكريا آخر يستولي على السلطة، ويشق عصا طاعة الخليفة في بغداد، كان القائد هو الضابط التركي أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، أول الدول التي نسميها "الدول المتمصرة المستقلة"، وهي دول استقلت فيها إرادة مصر الوطنية، لكن في ظل حاكم أجنبي، وإدارة أجنبية تعاونه ففي عام 871م، وإثر الفوضى التي أعقبت ثورة الزنج في البصرة، استغل حاكم مصر أحمد بن طولون انشغال الخليفة المعتمد بحال العراق وأعلن استقلاله عن الخلافة، وبنى لجيشه وبطانته التركية مدينة القطائع، وهزم جيش الخلافة الذي حاول استرداد مصر من قبضته، وبقيت مصر مستقلة حتى خضعت لبغداد في نهاية عصر خمارويه بن طولون، ثم استعادت استقلالها بوصول عسكري جديد للسلطة واستقلاله عن الخلافه، هو محمد بن طغج، إخشيد مصر ، واستمرت دولته ودولة عبده الخصي كافور الذي خلفه على عرش مصر حتى الغزو الفاطمي من شمال أفريقيا عام 969م. وبعد قرابة المائة وستين عاما من الازدهار الذي كانت مصر عاصمته وكانت القاهرة حاضرته، ضعفت الخلافة الفاطمية وبدأ عصر الوزراء العظام، وفي ظروف معقدة يضيق بها المقام وصل ضابط كردي من أكراد العراق لعرش مصر، مسقطا الخلافة الفاطمية، ليؤسس دولة عسكرية متمصرة جديدة، هو السلطان صلاح الدين الأيوبي، وامتازت مصر في عهده بدور قيادي في المنطقة العربية، حيث انضوت تحت إمرته أراض سوريا وفلسطين ولبنان حاليا، وقاد الجيش المصري النضال ضد الحملات الصليبية على الشرق في صفحات مجيدة من تاريخنا.
لكن ما حققه صلاح الدين من مجد لا يلغي ما حدث بعهده من قمع، فإنجازات صلاح الدين الأيوبي في الخارج لا تنفي طغيان وزيره "قراقوش" الذي تعسف في جباية ضرائب باهظة من المصريين حتى ضربت به الأمثال حتى اليوم، ولا تنفي سماحة صلاح الدين الدينية دموية أخيه العادل في قمع تمرد أقباط قفط، والذي سجل المقريزي في خططه قتل 3000 قبطي على أثره. وفي كل الأحوال كانت الدولة الأيوبية متمصرة لا مصرية، حيث كان حكامها أكرادا وكانت الإدارة والمناصب الرفيعة فيها للكرد والمماليك الذين اصطنعهم الأيوبيون وتوسع في استعمالهم الصالح أيوب آخر الملوك الأيوبيين.
العصر المملوكي آخر الدول المتمصرة
بدأت الحقبة المملوكية في مصر بسلطانين مملوكيين عظيمي الهمة، هما الملك المظفر سيف الدين قطز، قاهر التتار في عين جالوت، ثم الملك الظافر ركن الدين بيبرس محرر القدس للمرة الثانية ، وانتهت بسلطانين شريفين هما قنصوة الغوري ثم طومان باي، إذ استشهد كلاهما في مواجهة الاحتلال العثماني دفاعا عن استقلالها، أما بينهما فكان عصر تدهورت فيه أحوال مصر، وزاد البون الشاسع بين المصري الكادح من أولاد الفلاحين، والمملوكي المرفه من "أولاد الناس" كما أطلق عليهم المصريون. لكن مصر في كل الأحوال حافظت على استقلال إرادتها، وازدهرت فيها فنون العمارة والمنمنمات وهي فنون ارتبطت براحة ورفاهية ومجد المماليك أولاد الناس دون معظم أولاد البلد، وبوفاة السلطان طومان باي الذي قاوم العثمانيون في معركة الريدانية وبعدها زمنا، وتعليق جثمانه على باب زويلة، توفيت آخر دولة متمصرة مستقلة في التاريخ، ودخلت مصر عصر انحطاط جديد فقدت فيه إدارتها الوطنية واستقلالها وصارت تابعة للباب العالي في الآستانة، وعانى المصريون أسوأ أنواع القمع في تاريخهم على الإطلاق تحت هيمنة أبناء عثمان طغرل القساة غلاظ القلوب، وعادت مرحلة نزح خيرات مصر لخارجها.
جسر الكرامة-03
من نظرة عملية بدأ الاضمحلال الثاني مع حكم الملكة "سوبك-نفرو"، والذي دام ثلاث سنوات عاطلة من الإنجازات، فرغم أن أغلب المراجع التاريخية تربط نهاية حكمها وليس بدايته بالانحطاط الثاني، إلا أن دروس التاريخ تعلمنا أن توقف الإنجازات والنماء والبناء هو طليعة الانحطاط.
زادت الفوضى مع حكم الأسرة الثالثة عشرة ضعيفة النفوذ، واستمرت مع الأسرة الرابعة عشرة، فتكرر غزو الهكسوس لمصر، واستقر لهم حكم الدلتا، وتكررت مشاهد الانحطاط الأول وامتدت حتى تجاوزت قرنين من الزمان، حكمت فيها أسرتان من الهكسوس هما الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
الفجر الجنوبي من جديد
من حكام طيبة تأسست الأسرة السابعة عشرة التي شكلت البيت الحاكم المصري في ظل احتلال الهكسوس للدلتا، وتزايدت قوتها حتى قاد حاكم طيبة "سكنن-رع-تاو" حملة قوية ضد الهكسوس واستشهد فيها، فخلفه ولده "كا-موس" في قيادة الجيش ولحق بوالده شهيدا، ليخرج ولده الثاني "أحمس" من الجنوب طاردا الهكسوس في الملحمة الشهيرة للتحرير المصري، وتبدأ المملكة الحديثة من تاريخ مصر الفرعونية، وفيها حكم مصر أعظم فراعنة وسعوا سلطتها وأمنوا حدودها، في عصر عرف بمصر الإمبراطورية، ومن طيبة قلب الجنوب حكم فراعنة عظام بحجم "آمون-حتب الأول"، "تحتمس الثالث" ، "حتشبسوت" ، و"رمسيس الثاني" . ودام المجد لأكثر من خمسة قرون قبل أن ندخل في ثالث عصور الانحطاط. وأطولها على الإطلاق!
أطول عصور الانحطاط
انتهى حكم الأسرة العشرين من الدولة الحديثة والمعروف بحقبة الرعامسة بفرعون ضعيف هو "رمسيس الحادي عشر"، ودخلت مصر عصر الانحطاط الثالث حوالي عام 1050 ق.م.، حين حكمت المؤسسة الدينية من كهنة آمون الجنوب من طيبة، وعلى رأسها الأميرات حاملات لقب "زوجة الرب آمون" ، وحكم الفرعون الدلتا، وكان هذا هو الخلط الأول في مصر القديمة بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، حيث اعتاد الفراعنة منذ عهد "أحمس" وضع أحد سيدات البيت الملكي على قمة المؤسسة الدينية، حتى يتحكموا فيها، ولكن بمرور الوقت، ولوجود حق إلهي للأميرات في الحكم بفضل الدم الملكي، بدأت المؤسسة الدينية بقيادتهن تظهر ولاء متناقصا للسلطة المركزية، حتى صارت أشبه بسلطة مستقلة في عصر الاضمحلال الثالث هذا. واستعانت المؤسسة الدينية على هذا الاستقلال بشبه تحالف مع حكام النوبة جنوب الشلال الثالث. وخضعت مصر في مطلع الانحطاط الثالث لسلطة غير مباشرة للآشوريين.
والسواد الأعظم من المؤرخين يعتبرون انفصال "بسماتيك الأول" عن الدولة الآشورية في عام 656 ق.م. هو نهاية هذا الاضمحلال، وبهذا يكون امتداده لقرابة الأربعة قرون فقط، لكننا نرى أن هذا العصر امتد حتى الدولة الطولونية في العصر العباسي المتأخر، فلماذا؟
استبدل "بسماتيك الأول" نفوذ الآشوريين بنفوذ جديد لليديين ، كما استعان في جيشه بكبار ضباط من المرتزقة اليونان، وأقطعهم أراض واسعة في مصر، وبهذا وحد "بسماتيك الأول" المملكة وحقق استقرارا نوعيا دام بعده حتى حكم حفيدة "بسماتيك الثالث"، أي لأكثر من المائة عام، لكن الاستقرار هنا كان على حساب استقلال مصر وحريتها، وكانت نتيجة طبيعية لتلك التبعية أن تسقط مصر كثمرة ناضجة في يد الفرس إثر موقعة بيلوسيوم في عهد ذلك الحفيد. فالدول التابعة لقوى خارجية تكون هشة ومفرغة من الداخل بطبيعتها، ذلك أن التبعية والحس الوطني والترابط والتماسك في الجبهة الداخلية أضداد لا تجتمع، وحالنا اليوم خير دليل.
من هذا التاريخ، 1050 ق.م.، وحتى اعتلى الضابط المغامر أحمد بن طولون سدة الحكم في مصر في القرن التاسع الميلادي، أي لأكثر من ألفي عام، كافح الشعب المصري كفاحا اتصل حينا وانقطع حينا، وشهد لحظات مجد تاريخية لا ريب فيها، لكن تلك اللحظات كانت فلاشات في ليل طويل بهيم، لا يمكننا أن نجد بينها عصر استقلال إرادة وطنية كامل، أو مشروع حضاري نهضوي شامل وممتد.
حاول ملوك الحقبة المتأخرة من تاريخ مصر القديمة التمرد على النفوذ الفارسي، وحقق بعضهم نجاحات لكنها كانت عادة بدعم من اليونان والاسبرطيين، ثم صارت مصر قطرا من أقطار الامبراطورية الهيلينية التي أسسها الإسكندر الأكبر، وورثها عنه البطالمة، ثم قنصها الرومان. وهكذا صار تاريخنا مسلسلا من التبعيات لقوى وشعوب خارج حدود مصر.
النظام العالمي القديم والنزح الاقتصادي
كما تحكمت الولايات المتحدة وحليفتها الأصغر المملكة المتحدة في مقدرات العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى اليوم، وزادت سطوة قبضتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فقد حكمت روما القديمة العالم تحت شعار السلام الروماني (باكسا رومانا)، ونزحت ثروات شعوبه، وزعم الرومان أنهم بهذا يحققون رخاء البشر بضمان السلام والاستقرار والأمن عبر الأراضي الخاضعة للنسر الروماني. وكغيرها من الأقطار بدأت سياسة النزح الاقتصادي المنظم لمصر، والتي لم تنته إلا في نهاية العصر العباسي لفترات متقطعة، تخللها عودة للنزح كل حين.
فرض الرومان الضرائب المالية والعينية على الغلال والمحاصيل والبهائم بنسب باهظة وعشوائية، وغير مرتبطة بفيضان النيل طبعا، حتى جاع المصريون بينما سفن النسر الروماني تعبر بالغلال من الإسكندرية لروما في العهد الروماني الأول ثم للقسطنطينية في عهد الامبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية). واستمر الحال على ما هو عليه رغم تحول الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطورية مقدسة إثر تبني قيصر قسطنطين للمسيحية، عقيدة الرحمة والسماحة والحب، لم تقل الجباية حبة قمح واحدة، فلو كان يسوع الناصري عليه السلام قال بأن دخول الجمل من سم الخياط أصعب من دخول الغني لملكوت الرب، فقد قال كذلك "أعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر"، وفسرها بولس الرسول على هوى قيصره، والذي كان يرى أن ما لقيصر هو ببساطة كل شيء يريده قيصر! وقد ركزت كتب التاريخ المدرسية كما أذكر دوما على اضطهاد المصريين الأقباط الأرثوذكس على يد الرومان الملكانيين، والحقيقة أن القاريء المدقق لتاريخ مصر الذي سجله الآباء الأقباط يرى المعاناة الاقتصادية أفدح بكثير من الاضطهاد المذهبي.
ثم انتصر العرب بقيادة عمرو بن العاص على الرومان وأخرجوهم من مصر، فصارت تابعة لدولة الخلافة العربية في عهد عمر بن الخطاب، ثم للامبراطوريتين الأموية فالعباسية. فهل تغيرت الصورة كثيرا مع انتقال مصر لقبضة العرب بعد الروم ؟ ربما اختفى الاضطهاد المذهبي وقتيا مع الفتح العربي، لكن النزح الاقتصادي لمصر استمر قطعا، بل زاد تحت حكم ولاة مثل "عبد الله بن أبي سرح"، والذي زاد الجباية ليتمكن من توسيع فتوحه في أفريقيا، بينما كان ولاة معتدلون مثل "عمرو بن العاص" يجبون وفقا لمنسوب النيل وبنسب معقولة لا تقصم ظهور المصريين.
جسر الكرامة-02
مشكلة كبيرة وجد مؤرخو العهد القديم من الكتاب المقدس أنفسهم فيها بعد أن فك شامبليون شفرة الكتابة المصرية القديمة بفك رموز حجر رشيد، وترجمة متون الأحجار واستنطاقها لتحدثنا بتاريخ مصر المجيد، تلك المشكلة هي غياب أي ذكر للأحداث الجسام التي ذكرها العهد القديم حول مصر من برديات المصريين وحجارتهم التي سجلوا فيها أحداثا أبسط وأقل أهمية من تلك الواردة في الكتاب المقدس، فكيف غاب التاريخ اليهودي المقدس من ذاكرة دولة كانت تسجل حوليات دقيقة منذ فجر التاريخ؟
لا يوجد ذكر في التاريخ المصري لأحداث ترتبط بدخول النبي إبراهيم لمصر وموجات اللعنة التي حلت بمصر من جراء استئثار الفرعون بسارة زوجة إبراهيم عليه السلام لنفسه،لم يذكر تاريخ مصر شيئا عن تحول ماء النيل إلى دماء، ولا عن غزو من القمل والضفادع والجراد. كذلك لم يسجل التاريخ المصري غرق جيش مصري بقيادة فرعون شخصيا في البحر الأحمر أثناء مطاردة للعبرانيين. ولا سجلت قصة وزير أو موظف كبير في مصر من أصل عبراني هو النبي يوسف عليه السلام، فكيف يتصرف مؤرخو الكتاب المقدس في هذه المعضلة؟
لم يكن عصر الاضمحلال الذي شهد أسرا من الملوك الرعاة (هكسوس) من خارج مصر عصر تدوين بحال من الأحوال، فلم يكن الملوك الرعاة مشغولين بالأبدية كالمصري القديم، لم يهتموا بحفظ تاريخهم، ولذلك كانت الأسرات المالكة الأجنبية من السابعة للعاشرة بغير تراث تقريبا، إلا شذرات، وفي هذا وجد مؤرخو الفاتيكان ضالتهم، فألصقوا كل تلك الأحداث بالملوك الرعاة، وإن لم يعجب هذا الحل اليهود كثيرا، حيث فضلوا دوما إلصاق تلك الأحداث بملوك عظماء من الدولة الحديثة أشهرهم "رمسيس الثاني".
الشمس في مصر تشرق من الجنوب!
ظاهرة تسترعي نظر الباحث المتأمل في تاريخ مصر بكافة مراحله، فبعد فترات الاضمحلال والفوضى، والتدخل أو الاحتلال الأجنبي، يخرج أبطال التحرير غالبا من جنوبها، وبعد حقب الجهل والظلام تشرق شمس التنوير كذلك من جنوبها في أغلب الحالات.
دائما الجنوب، صعيد مصر، وجنوب أسيوط تحديدا، ولهذا أسباب ليس هذا مقامها. فكما خرج "مينا" موحد القطرين من طيبة، ليؤسس الأسرة الأولى التي حكمت مصر الموحدة لأول مرة في تاريخها قرابة عام 3200 ق.م.، خرج منها "مونت-حتب" الثاني مؤسس الأسرة الحادية عشرة والدولة الوسطى لينهي الفوضى ويضم مصر بكل أقاليمها تحت حكمه، ويتم ما كان سلفه نخت-نتب-نفر قد بدأه بالتعاون مع حكام أسيوط لطرد الملوك الرعاة من الدلتا تدريجيا، واستأنفت مصر مشوار الحضارة والعمران وعمرت المعابد، وعادت للآلهة سلطتها القديمة، واستقرت العادات والتقاليد التي كانت فترات الجوع والفوضى قد رجتها بعنف مبرح.
وازدهرت الدولة الوسطى وعرفت أسماء فراعين لامعة في غرة التاريخ، فكان منهم الفرعون الشعبي المغامر الذي استولى على السلطة وأسس الأسرة الثانية عشرة، "أمنمحات الأول" أو "سي-حتب-رع"، والذي نقل العاصمة للفيوم لمواجهة محاولات الرعاة العودة لمصر من الحدود الشرقية، وخلفه ابنه "سنوسرت الثالث"، صاحب قناة سيزوستريس الشهيرة، وأول فرعون اهتم بالفتوح الكبرى خلف الحدود، فضم لنفوذ مصر النوبة حتى الشلال الثالث وجبل لبنان وفلسطين. واستمر النماء والبناء في عهد ولده "أمنمحات الثالث".
جسر الكرامة-01
كما عرفت مصر منذ فجر التاريخ الحضارة والإنجازات الإنسانية الشامخة، عرفت كذلك عصورا تردت فيها حضارتها وتقزمت إنجازاتها، كما عرفت فراعنة وملوكا وحكاما كبارا صاغوا سيرتهم في تاريخها بحروف الذهب والنور، عرفت فراعنة وملوكا وحكاما كرهت مصر أسماءهم فتناستها، أو احتفظت بها في قبو الظلمات، مكتوبة بمداد أسود بلون الهم والرماد، ضمن عصور التدهور والتردي التي اختلف علماء المصريات والمؤرخون في تسميتها، فمنهم من كان شديد الصراحة فأسماها باسم يناسب واقعها، هو "عصور الانحطاط"، ومنهم من كان مجاملا بعض المجاملة فأطلق عليها "عصور الاضمحلال"، ونراها تسمية مجاملة قليلا لأن الاضمحلال يناسب الفترات المبكرة من تلك العصور، حيث كانت المدنية والحضارة تتقزم والإنجازات تتضمحل، ولا تختفي تماما، لكنه لا يناسب قلب تلك العصور الذي كان فوضويا في مجمله، فهو محاق للحضارة وليس مجرد اضمحلال، كذلك كان من المؤرخين من خرجت به المجاملة واللهجة الإيجابية عن الموضوعية برأينا فسماها "عصورا انتقالية"، وهو اسم غير موضوعي، وإن كان الأحدث والأكثر شيوعا في الوقت الراهن في المقالات التاريخية التي تتناول تلك الفترات، نراه غير موضوعي لأن للعصر الانتقالي سمتان مفترضتان فيه منطقيا:
1. جذور في العصر السابق عليه أدت لبدايته، وهذا العنصر متوافر في حالتنا.
2. بذور للعصر التالي متجانسة معه، وتؤدي لبزوغه بغير تغيرات جذرية ولا ثورية، وهو ما تفتقر إليه عصور اضمحلالنا بصفة عامة.
ومن أمثة المراحل الانتقالية مثلا نجد الفن القبطي كمرحلة انتقالية بين الفن المصري القديم والفن في مصر الفاطمية، فقد كان انتقاليا لأنه حمل سمات السابق عليه وبذور اللاحق به. وهو ما يغيب عن عصور التدهور السياسي في تاريخنا الطويل والممتد، والتي كانت تنتهي عادة بأحداث ثورية أو استثنائية أو مبادرات فردية.
عصر الانحطاط الأول
بعد الازدهار والمجد التليد الذي بنته الدولة القديمة في مصر الفرعونية، وبعد فراعنة بوزن "مينا" موحد القطرين، و"سنفرو" و"خوفو" و"كاف-رع" و"منكاو-رع"، ممن دلتنا الأهرام على عظمة حضارتهم، اعتلى عرش مصر في نهايات الأسرة السادسة حاكم ضعيف الهمة والشخصية والطموح هو "بيي الثاني"، وقد استمر في الحكم حتى نيف على التسعين، واهترأت في عصره أجهزة الدولة وشاخت بشيخوخته، واكتملت الكارثة في نهاية عهده الطويل بأعوام جفاف متتالية انخفض فيها منسوب النيل، ورفض الفلاحون سداد الضرائب في بعض الأقاليم وطردوا جباة السلطة المركزية، لتنهار تلك السلطة التي ميزت مصر الموحدة المتماسكة عما حولها من أقطار، وعندما فسد الجسد من الداخل ضعفت مناعته فهاجمه الوباء، واجترأ الرعاة على حدود الدولة الشرقية عليها لأول مرة منذ مطلع حكم بيبي الأول، والذي أحبط هجمتهم البربرية الأولى، قبل أن يجترأوا على خلفه الضعيف، وعاث البدو حاملي السهام كما يحدثنا مانيتون في البلاد سلبا ونهبا فتضاعف القحط والخراب، وانتهت الأسرة السادسة بموت الفرعون العجوز ودخلت مصر عصر الانحطاط الأول، والذي امتد لقرابة الأربعمائة عام.
وتسهب البرديات القديمة في وصف الشقاء الذي حاق بالمصريين جراء انفكاك الأمر في دولتهم المركزية، ففضلا عن البدو الساميون الذين حكموا الدلتا وصاروا سادة فيها واستعبدوا المصريين، احتل البدو الليبيون مصر الوسطى وأسسوا مملكة فيها ما بين أقاليم الشمال الخاضعة لبدو الشرق وأقاليم الجنوب التابعة لحكام طيبة المصريون. وانهارت منظومة القيم والأديان وعمت فوضى أخلاقية سنراها دائما مصاحبة للتردي الاقتصادي في مصر عبر العصور، تحل معه وتزول بزواله. وقد عرضنا لعصر الاضمحلال الأول هذا كمثال لغيره من عصور الانحطاط التي مرت بنا عبر تاريخنا، قبل أن نرصدها في عجالة لننفذ لمحتوى هذا العمل الأساسي.
2.6.10
الثورة البيولوجية والفكر الديني
- قصة الخلق القرآنية لا تتعارض في فهمها المعاصر مع نظرية أصل الأنواع التي حولتها الأنثروبيولوجيا الحديثة إلى مسلمة علمية، أما التعارض البادي بين الروايات التراثية وعلم التطور فسببه مصدر تلك الروايات، وهو العهد القديم الذي فقدت البشرية نصه بلغته الأم وبالتالي فقدت عبقريته ومرونته اللغوية
- كذلك تستوعب قصة الخلق في القرآن نظرية الانفجار الكبير والتمدد الكوني وتقصر عنها الروايات التراثية لابن كثير وغيره، مع احترامنا لجهدهم في حدودهم الزمنية والمعرفية
- التعريف القرآني للخلق هو الخلق من العدم (عدا حالة الخلق التطويري للإنسان) وبطلاقة القدرة، وبهذا يحتفظ الخلق الرباني بتفرده أمام المنجزات الإنسانية بما فيها تركيب الخلية الحية من مادة أولية ميتة، لأنه خلق من موجودات سابقة وبقدرات موارد محدودة قابلة للنفاذ، وهنا نفهم عبقرية اللفظ القرآني في تعبيره عن الله تعالى بأحسن الخالقين
24.9.08
أوتوجرافات الوهم

محمد عليه الصلاة و السلام
المجموعة التالية لاسم سيدنا محمد (ص) وتبدأ بالسحاب ثم برتقانة وبيضة وتحتهم شمامة، إنما الجامد قوي بقى الأخ اللي اكتشف الاكتشاف المذهل اللي جنبهم ده، إن البني آدم وهو نايم على ضهره هيكله العظمي بيكتب اسم الرسول! كان نفسي أبعت للأخ ده أسئل بيتعاطى ايه علشان أعرف دماغ إيه اللي بتعمل كده؟ ومستغربين من الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول؟ هو الادعاء بوجود اسم الرسول على فاكهة الموسم ليس فيه سوء أدب معه صلوات الله عليه؟
المهم إن ما يدعونه دوما توقيعا باسم الله أو الرسول أو غير ذلك، هو إما تجريح في قشرة الفاكهة في أول النمو (و يسهل لهذا اختلاقه) أو عيوب تكوين في قشرة البيضة، يعني خلل، يعني الرسول اسمه هيظهر من خلال عيب في الثمرة ولا البيضة؟ ولا ربنا هيكتب اسمه بعيب خلقي في وش عيل؟ ألا يكون الله ورسوله أكرم علينا من ذلك؟
طبعا المجموعة دي واللي قبلها من مواقع اسلامية، ونجد اسم الله أكتر شيوعا في هذه المعجزات من اسم محمد (ص) لأن أي ثلاث خطوط متجاورة ورابع أقصر منها وفيه التواء يمكن توهم اسم الله فيه، لكن الميم والحاء في اسم الرسول تجعل الموضوع أصعب قليلا ، لذلك يكثر فيها الاختلاق من خلال برامج الجرافيك أكثر من الاعتماد على الصدف والعيوب العشوائية في الثمار وغيرها
وحتى "علي" إمام المتقين
طبعا إخوانا الشيعة عيب يسكتوا، جابوا من الآخر بقى وقالك ولا فاكهة ولا بتاع، القمر نفسه مكتوب عليه "علي"، وطبعا واضح مدى الوهم والتخريف، واللي جنبه دي بيضة تفاريح للعيال كده عليها اسم الإمام، بس بخط عربي جديد اسمه "الخط البهلولي" يكتب به البهاليل تخاريفهم وكذبهم، وجنبها تلاقي الشجرة اللي بتبكي دم كل يوم الفجر على سيدنا الحسين في العراق، رضي الله عنك يا سبط رسول الله، بذلت نفسك الطاهرة في كربلاء لتعطينا المثل على الثبات في الحق بعيدا عن حسابات الربح والخسارة، وواجهت أبناء الزواني ببضعة من أهلك وهم قد جيشوا لك جيشا، فهل نفعنا المثل يا سيدي وهل فهمناه أو عملنا به؟ أم حسب المخاليل والبهاليل أنهم بتوهم صورتك أو اسمك أو شجرة تنزف عليك حزنا قد أوفوك حق التضحية؟
بأسفل تلاقي عيل غلبان مولود بوحمة هيصرف عليها دم قلبه لما يكبر علشان يشيلها بالليزر، يقولك ده ابن شهيد واسم سيدنا علي على وجهه تكريما لأبيه، واحد تاني قالك لأ، ده اللي على وشه اسم "علاء" اللي هو اسم والده الشهيد، يا سلام، لو كل شهداء حروبنا خلفوا عيال ممضي عليهم كده كانت البلد بقت ملك، سبحان الله! جنبها بقى مع التقدم التكنولوجي واحد قالك بلا أسامي بلا كلام فارغ / إديها ديجيتال ووتر مارك، وآدي وش سيدنا الحسين ظهر على الحجر! اللي في الآخر دي بقى صورة للشيعة بيلمسوا الركن اليماني يوم ميلاد سيدنا علي علشان بيطلع عليه فطر معطر الرائحة كل سنة في تلتاشر رجب، لأن السيدة فاطمة بنت أسد ولدته رضي الله عنه في ذلك اليوم داخل الكعبة، علشان كده الإمام كان يسمى وليد الكعبة، شفت التجلي ده كله؟ طبعا الشوية دول من مواقع شيعية، بس دول شيعة غير شيعة حزب الله ، لإن لو حزب الله كانوا فكروا كده كان بقى عليه العوض وكان زمان اسرائيل في شمال لبنان مش طلعت من الجنوب، فلا داعي لأن يفرح المعادون لشيعة آل البيت، الهم طايلنا وطايلهم في خفاف العقول مش في المناضلين
طبعا لأن توحد صفوف الشعب في الهطل واحدة من ركائز الوحدة الوطنية في بلادنا، ماكانش معقول إخواننا الأقباط في مصر هيقعدوا كده، وطبعا الصليب مية مية، اي خطين متعامدين بقوا صليب، فخيرك بقى .. شجر وحجر وجبل وورد وفراشة ، بس اللي جامدة قوي الدراع اللي فيها غرزتين دي ، بيقولك الولد المتعور ده ابوه مرضيش يدقله صليب، طبعا لأنه راجل علماني ووحش، فكان انتقام السماء، قالك ربنا أصابه بجرح هنا عند الرسغ، والتعويرة تسيب صليب في نفس مكان الوشم، يعني ربنا أبو الواد ضايقه قام معور الواد؟ يا صلاة النبي؟ ده إيه الفتوح ده كله؟ طيب مش كانت ماما تاخد بالها من رضيع زي ده بدل ما تقول إن رب العزة هو اللي عوره؟ أستغفر الله العظيم من سوء الأدب مع الله والجرأة على الله؟
دول بقى غلبوني علشان ألاقيلهم حاجة ملقيتش غير الكام صورة دول عند يهودي أهبل واحد، واحد بس، طبعا، مدام ناس بشغلهم خاتمين العالم كله على قفاه مش هيفضوا للهبل والإمضاءات دي، أصل كل دي يا إخواني وسائل ملتوية لتحقيق الذات، لما تيجي لشاب ضايع وصايع وتافه ، محتاج يحقق ذاته ويحس بتميز، يقوم يحس ازاي؟ يحس من خلال إنه الوحيد اللي على دين حقيقي والباقي واهمين ، حتى بص الفاكس الإلهي اللي جاي على الوردة ولا الشجرة ولا البيضة واللي سلقها واللي شواها 
حتى الجوتاما بوذا؟
السمكة دي بقى من موقع بوذي ، وعينها ما شاء الله فيها صورة بوذا لو دققت قوي تشوفها، بوذا الذي لم يدع لنفسه أبدا أية قداسة ولا ألوهية ولا حتى نبوة، عاش ومات فيلسوفا مثل زرادشت، لكنه لم يسلم من هبل أتباعه، بالطبع لا أتوقع أن يكون من ضرب هذه الصورة بالجرافيك بوذي ياباني، ده شغل ناس فاضية، ممكن يكون هندي ولو أن الهند اليوم بدأت تأخذ طريقها لتغادر مؤخرة العالم التي نحتل نحن منها موضع فتحة الشرج، لتتركنا نستمتع بفضلات العالم منفردين، وما زلنا نحن نقول "إنت فاكرني هندي؟" للدلالة على العبط ، واحنا قريب ان شاء الله مش هيكون فيه أعبط منا ، وهيعملولنا خانة لوحدنا يسموها الدول موقوفة النمو، كمرحلة أدنى من تلك النامية

على اسم مصر
وقف الخلق ينظرون جميعا، دي بقى المعجزة الحقيقية الوحيدة في هذه الصفحة ، معجزة العلم والبحث والإبداع المصري الذي كان، ده تمثال رمسيس التاني اللي الشمس تدخل على وشه جوه معبده في يومين في السنة، يوم الميلاد ويوم التتويج بالتحديد، ده قبل ما نبقى أمة ضحكت من جهلها الأمم، قبل ما نشرب المانجة ونتهطل، ويتنقل المعبد وتمر آلاف السنين ومازالت الطبيعة صاغرة أمام علم المصريين الذين كانوا، هل يمكن أن نكون نحن أحفاد هؤلاء بحق؟ ده بقى بيفكرني بافتكاسة قوية جدا واحد علامة كوني خارق زي الداعية الجيولوجي كده بس أنكى وأشد، تعالوا نشوف مع بعض الهرتلة

نحن أحفاد قوم عاد ، وإرم هي الأقصر وكليوباترا اسمها وفاء، ورقصني يا جدع
لا مش هزار ده واحد فاكر نفسه بيتكلم جد ، وطابع كتاب وعامل موقع وحكاية جامدة جدا لقالها كام مهطول من مشايخ الزيت يصرفوا عليها والقشية بقت معدن ، النظرية قامت على صور جابها الأفندي من النت وماخدش باله إنها كانت نازلة في مسابقة لجرافيك الحفريات والأساطير، عملتها وكالة ناسا لخدمة تصوير فيلم، الصور دي لهياكل عظمية عملاقة، زي الصور اللي تحت دي، قالك الفراعنة دول لصوص سرقوا آثار قوم عاد وحفروا اسمهم عليها، وكمان كليوباترا دي اسمها الحقيقي "وفاء" (وأخوها اسمه حسن بالمرة بقى وواخد حكم في قضية إحراز سلاح)، وقالك إن إرم ذات العماد هي الأقصر، بس إحنا مضيعين، وكمان "آمون" اللي اسمه بيتردد من قبل اللغة الآرامية ما تطلع منها النبطية اللي طلعت منها العربية، طلع يا سيدي أصل اسمه "آمين" بس حرفت، وقالك إن اللي اكتشف الحكاية دي الأمريكان بس ساكتين علشان هم كمان بيقولوا آمين زينا، على فكرة الموضوع بتاع آمين ده له أساس، كان فيه بحث كده فعلا بس بالعكس، بيطرح إمكانية تطور آمين من آمون الفرعونية، لأن الفراعنة كان عندهم صلاة يردد فيها الكاهن عدد من الصفات الألهية وبعدها الناس تقول مع بعض "آمون" لنسب الصفات ليه، اللي الحمار ده ميعرفهوش إن الفكر ده فكر إلحادي تماما، لأنه فكر يقول بتطور الأديان الإبراهيمية من العقيدة المصرية عن طريق اليهود اللي عاشوا في مصر فترة، وغاروا من آلهة الأقاليم فابتكروا "يهوه" رب إسرائيل زي بتاح وسيت وغيرهم، يعني الضال المضل بيروج لفكر منكر للأديان السماوية، والناس تهلل، وييجوا على الشهيد العالم "فرج فودة" ويقولوا عليه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة؟ آه يا بلد! الصورة بأسفل للهيكل العظمي من موقع من يسمون أنفسهم موقع أهل السنة والجماعة، فهل من حق أحد أن يقول أنه الناطق باسم كل من يتبع السنة النبوية المشرفة؟ وهل هذه صورة يضعون عليها شعارهم وينسبوها لأهل السنة؟؟

كيف ترى الله؟
سبحان الله المرئي في الكون وفي أنفسنا بغير ألعاب سيرك، سبحان الله الذي أراه في فطرة الإنسان ميالا للحق والخير والجمال مجفلا من القبح والشر والضلال ، وقدرة الله أراها في المجموعة النجمية فالمجرة فالكون المنظور فالأكوان الفرضية، وقدرة الله أراها في غرس قابلية التطور بالطفرات في الحيوان لتتطور الكائنات، وهو ما أنكره المهاطيل رغم كونه حقيقة علمية لا تقبل جدلا اليوم، ولا أرى في هذا تعارضا مع بداية الكائنات العاقلة ذات الوجدان والضمير مع آدم أبي البشر، سبحان الله في عظمة العقل البشري الذي يمر بطفرات كل يوم، والله ما أنكر المنكرون ولا جحد الجاحدون إلا بسبب العقلية الغوغائية هذه في فهم الدين، والبهاليل الذين يهللون لبدع وضلالات داعية الجيولوجيا العقيمة، وينفقون الملايين على صفحات مدفوعة له في الأهرام يتكلف المقال الواحد منها قرابة النصف مليون جنيه! متى نرجع لطريق العلم ونترك الخرافات؟ متى تظهر خوارزميات رياضية جديدة ممن ينتمي لهم الخوارزمي؟ صاحب أول آلجوريزم رياضي؟ لا أدري، لكن المؤكد أنني لن أعيش لأرى هذا اليوم ، فالإنسان عادة لا يعيش لعدة قرون رغم كل ما قاله ابن كثير الله يرحمه
3.9.08
المعروف و المنكر في القرآن
- المعاملات بين الزوج و الزوجة: كقوله تعالى في حالة مراجعة الزوج لزوجته "إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (البقرة:228) ، و قوله بشأن عدد مرات الطلاق و الإمساك بعدها "ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ" (البقرة:229) ، و كقوله تعالى في نفقة المرضع "وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ" (البقرة:233) ، و في نفقة المطلقة "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ" (البقرة:236) ، و قوله تعالى في الصداق "فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ" (النساء:25) ، و قوله تعالى في العدة بعد الطلاق "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" (الطلاق:2) ، و هذا من حكمة الله و عظمة القرآن ، أن ردنا الله في المعاملات الزوجية و ما يحسن للمرء أن يعامل به زوجه إلى معيار متغير ، و هو ما يجتمع الناس على حسنه و بره من السلوك ، لأنه موضوع وارد فيه التغيير الكبير بتغير المجتمعات البشرية و تغير البيئة المحيطة
- المعاملات الأسرية مثل العلاقة بين الأبناء و الأبوين: كقوله تعالى في الوصية قبل نزول أحكام المواريث "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ" (البقرة:180) ، و قوله تعالى في معاملة الوالدين "وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً" (لقمان:15) ، و هذا كذلك من حكمة الله تعالى ، فلو رأيت اللهجة التي يكلم بها البدوي المهذب البار أبويه ، لوجدتها مباينة لما أكلم به أنا أبوي و كلاهما مباين للطريقة التي يكلم بها الأمريكي البر المهذب والديه ، فالبر سلوك و تصرفات و لياقة تختلف من زمن لزمن و من مكان لمكان ، و نحن مطالبون بمعاملة الأهل دوما كأحسن ما يراه الناس في مجتمعا سلوكا حميدا خليقا بالرجل البار ، و قد يكون من البر المفروض على القادر اليوم أن يوفر لوالديه وسيلة انتقال كسيارة خاصة مثلا ، لأن بعض الأبرار يفعلون اليوم هذا ، فلو كان القرآن قد حرر قائمة بضروب البر جامدة لما شملت مثل هذا الضرب المستحدث من ضروب البر
- المعاملات المدنية و المعاملات اليومية بين المواطنين: كقوله تعالى في حالة العفو في الحدود "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" (البقرة:178) ، و قوله تعالى "قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ" (البقرة:263) ، و في تعامل النساء مع الرجال في الحياة العامة قياسا على قوله تعالى لأمهات المؤمنين "فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً" (الأحزاب:32) ، و في الإحسان إلى الناس و التكافل الاجتماعي: كقوله تعالى "وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً" (النساء:8) ، و هذه كذلك أمور متغيرة وفقا للزمان و المكان ، فمثلا ما كلن يعتبر خضوع بالقول و مطمع للرجال في مجتمع البعثة المحمدية ، قد لا يعتبر كذلك اليوم ، و العكس صحيح ، و كل امرأة في مجتمعها تعرف ماذا يليق و ماذا يخرج عن اللياقة في هذا الشأن ، دون الحاجة لتحديد جامد لفظي يصبح مع الزمن غير ذي موضوع
- التعامل مع المال العام و الوظائف و المناصب: و يقاس فيها على قوله تعالى في القائم على مال اليتيم "وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ" (النساء:6) ، لأن الأكل بالمعروف يختلف معياره في كل وقت حسب حد الكفاف في كل زمن ، و في كل مجتمع ، فما نعتبره نحن اليوم في مصر حدا للكفاف ، قد يكون أدنى من الكفاف بكثير في مجتمع مثل النرويج أو الدنمارك ، لهذا ردنا الله لمبدأ المعروف المرن و المتغير
فنحن نفهم المعنى القرآني المعجز للمعروف بأنه "ما تعارف الناس على حسنه و بره ما لم يحل حراماً" فمن عظمة القرآن الكريم أنه ردنا في معاملات البشر البينية لهذا المعيار المتغير المتطور ، و هذا لا ينطبق على حدود الله في تنظيم علاقة عباده به تعالى ، إذ يحكمها منطق الحلال و الحرام و ليس مبدأ المعروف و المنكر ، و لهذا فلو تعارف الناس على حرام ، لا يجعل هذا الحرام حلالاً ، فلو عشت أنا الآن في دولة تعارف الناس فيها على تناول النبيذ مع الطعام ، لا يحل لي هذا السلوك رغم تعارف الناس عليه ، لأن فيه اجتراء على ما حرم الله تعالى ، و هذا ليس أمرا يخص معاملتي مع الناس و لكنه يخص حد وضعه الله لي و أمرني أن ألتزمه ، كذلك نفهم "المنكر" في لغة القرآن الكريم بأنه "ما تعارف الناس على شره و خبثه و إن قنن حلالاً" ، فليس حرام علي أن أركب الدواب ، و لكن لو تعارف الناس اليوم على أن السير بالدابة في المدن الكبرى يعيق المرور و يعطل مصالح الناس العاجلة ، فقد صار ركوبها أمراً منكراً ، لان الناس توافقوا على كراهته ، و كذلك مخالفة قوانين المرور و القوانين المدنية هي أمور منكرة و إن لم تكن حراما ، لأن الناس تعارفوا من خلال نوابهم في المجالس التشريعية على كون خرق قانون المرور أمر منكر يضر بالصالح العام و يعرض حياة الناس للخطر ، و هكذا، و من هنا تتجلى لنا عظمة القرآن في ارتباط مفهوم المعروف بواجب الأمر به على كل مسلم ، و ارتباط مفهوم المنكر بواجب النهي عنه على كل مسلم ، و هذا ما نبينه هنا باستفاضة
لماذا اقتصر الأمر و النهي في اصطلاح القرآن على المعروف و المنكر؟
 و لماذا لم يقترن أمر أو نهي بالحلال و الحرام؟ السبب كما قلنا آنفاً ، أن المعروف و المنكر هما حدود معاملات الناس لبعضهم بعضاً ، أما الحلال و الحرام فيحكمان علاقة العبد بربه ، لهذا أمر الله الناس أن يتواصوا بما كان من المعروف و يتناهوا عما كان منكرا من الأمور ، لان في هذا صلاح دنياهم ، و لأن ارتكاب الآخر لمنكر قد يضرك أنت ، كأن يكون هذا المنكر سيرا بعكس اتجاه المرور على طريق سريع يعرض حياتك للخطر ، فلك كل الحق هنا أن تنهى و تنهر و تستدعي تدخل ولي الأمر ممثلا في الشرطة لو لم يجد النهي ، أما اقتراف الحرام فلا يضر إلا بصاحبه عدا في البغي و ظلم الناس ، فالبغي يجمع بين الحرمة و النكر ، و هو عنصر مؤثر على علاقة الفرد بربه ، الذي حرم على نفسه الظلم و جعله بيننا محرما ، كما هو مؤثر في علاقة الناس بعضهم بعضاً ، و هو حرام لأنه يظل ممجوجا من بدأ الخلق لنهايته ، و هو منكر لأنه يخص تعامل الناس مع بعضهم بعضاً ، و الآيات التي وردت بشأن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في كتاب الله كثيرة ، فمنها قوله تعالى "وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ" (آل عمران:104) ، و كذلك "يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـٰئِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ" (آل عمران:114) و غيرها الكثير مما يضيق به المقام هنا ، لكن من المواضع التي تؤكد فهمنا للمعروف و المنكر ربطهما بوسطية الأمة ، بأن وصف الله أمة الإسلام بالوسطية في قوله تعالى "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" (البقرة:143) ، ثم وصف أمة الإسلام بصفة الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر بقوله تعالى "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ" (آل عمران:110) ، و اجتماع الصفتين للأمة نرى فيه علاقة سببية ، لأن أية أمة ترتبط فيما يخص معاملات الناس و الحياة اليومية بمعايير ثابتة جامدة ، سيصل بها الحال لما وصل باليهود قبل المسيحية ، إذ قدسوا الطقوس و المعايير ، فتحول السبت من يوم راحة لهم ، إلى يوم عناء لأنهم جعلوه يوما للكسل المقدس ، أما معيار المعروف و المنكر فهو متجدد و عميق الصلة بالحياة و ديناميكيتها المستمرة ، و لهذا فهو الضامن للوسطية ، فلا نخسر كمسلمين صفة الوسطية إلا إذا ضللنا عن قاعدة المعروف و المنكر القويمة فنحمد الله على نعمة مرونة القرآن و مناسبته لتطور الزمان و المكان ، مرونة لا تجعله معاكسا لظروف المجتمع ، فننحرف عن مقاصده السامية ، لذلك برأ القرآن من كل عوج ، كقوله تعالى "ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا" (الكهف:1) و الله أعلم بما أراد
و لماذا لم يقترن أمر أو نهي بالحلال و الحرام؟ السبب كما قلنا آنفاً ، أن المعروف و المنكر هما حدود معاملات الناس لبعضهم بعضاً ، أما الحلال و الحرام فيحكمان علاقة العبد بربه ، لهذا أمر الله الناس أن يتواصوا بما كان من المعروف و يتناهوا عما كان منكرا من الأمور ، لان في هذا صلاح دنياهم ، و لأن ارتكاب الآخر لمنكر قد يضرك أنت ، كأن يكون هذا المنكر سيرا بعكس اتجاه المرور على طريق سريع يعرض حياتك للخطر ، فلك كل الحق هنا أن تنهى و تنهر و تستدعي تدخل ولي الأمر ممثلا في الشرطة لو لم يجد النهي ، أما اقتراف الحرام فلا يضر إلا بصاحبه عدا في البغي و ظلم الناس ، فالبغي يجمع بين الحرمة و النكر ، و هو عنصر مؤثر على علاقة الفرد بربه ، الذي حرم على نفسه الظلم و جعله بيننا محرما ، كما هو مؤثر في علاقة الناس بعضهم بعضاً ، و هو حرام لأنه يظل ممجوجا من بدأ الخلق لنهايته ، و هو منكر لأنه يخص تعامل الناس مع بعضهم بعضاً ، و الآيات التي وردت بشأن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في كتاب الله كثيرة ، فمنها قوله تعالى "وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ" (آل عمران:104) ، و كذلك "يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـٰئِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ" (آل عمران:114) و غيرها الكثير مما يضيق به المقام هنا ، لكن من المواضع التي تؤكد فهمنا للمعروف و المنكر ربطهما بوسطية الأمة ، بأن وصف الله أمة الإسلام بالوسطية في قوله تعالى "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" (البقرة:143) ، ثم وصف أمة الإسلام بصفة الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر بقوله تعالى "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ" (آل عمران:110) ، و اجتماع الصفتين للأمة نرى فيه علاقة سببية ، لأن أية أمة ترتبط فيما يخص معاملات الناس و الحياة اليومية بمعايير ثابتة جامدة ، سيصل بها الحال لما وصل باليهود قبل المسيحية ، إذ قدسوا الطقوس و المعايير ، فتحول السبت من يوم راحة لهم ، إلى يوم عناء لأنهم جعلوه يوما للكسل المقدس ، أما معيار المعروف و المنكر فهو متجدد و عميق الصلة بالحياة و ديناميكيتها المستمرة ، و لهذا فهو الضامن للوسطية ، فلا نخسر كمسلمين صفة الوسطية إلا إذا ضللنا عن قاعدة المعروف و المنكر القويمة فنحمد الله على نعمة مرونة القرآن و مناسبته لتطور الزمان و المكان ، مرونة لا تجعله معاكسا لظروف المجتمع ، فننحرف عن مقاصده السامية ، لذلك برأ القرآن من كل عوج ، كقوله تعالى "ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا" (الكهف:1) و الله أعلم بما أراد5.8.08
لآليء القرآن-07
 حتى لقد بلغت الجرأة ببعضهم أن يستخدم مطلع الآية الكريمة شعارا و تحتها السيفين! و الآية هنا يا سادة لا تتحدث عن الحرب ، و لكن عن تحقيق سلام القوة و تجنب الحرب و ويلاتها من خلال إكتساب القوة الرادعة ، و لا حديث عن الحرب ذاتها، و لا عن "الإرهاب" بمعناه الزمني اليوم ، و لكن الآية تحدثنا عن مفهوم "الردع السلمي" ، و هو الأسلوب الذي اتبعته أمريكا و الاتحاد السوفيتي مع بعضهما البعض خلال الحرب الباردة ، لأنهما حافظتا على موازين قوة ، تجعل حرب كل منهما مع الآخر مهما تفوق عليه، شيء مدمر فوق تخيل البشر، و لهذا لم تسخن الحرب الباردة ، و لن تتحرر الأرض الفلسطينية اليوم ، إلا لو امتلك العرب من أسباب القوة و مقوماتها ما يحرر الأرض بدون قتال، فعندما تمتلك القوة، تستطيع أن تجلس لمائدة المفاوضات، و غريمك يكره أن تقوم من عليها بغير اتفاق، و لكن حين تجلس في موقف الأضعف الغير واثق بقوته، فلا تكون المحصلة أكثر مما حصلناه بداية من "كامب ديفيد" و حتى اليوم ، و لم يفهم الدرس غير إيران التي تسعى حثيثا لامتلاك قوة الردع النووي ، و يوم تمتلكها ستتغير موازين القوة بالمنطقة ، و الآية تدعو المسلمين لزيادة الانفاق العسكري و عدم البخل عليه بالمال، لان الانفاق العسكري هو الحامي الحقيقي للسلام، و ذلك بقوله تعالى "وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ" و الناس لا تحتاج للتشجيع على الانفاق العسكري في غير وقت السلم، لان الضرورة في الحرب تجبرهم على ذلك، فلا الآية دعت للحرب و لا للإرهاب، و لكن لامتلاك القوة الذي يحمي السلام ، و الإرهاب فيها ليس بمعنى الإرهاب في زماننا، و لكن بمعنى الردع، و هذا معناه الحقيقي، لأن مصطلح الإرهاب المعاصر هو أمر اخترعناه للتدليل على ما كان يسمى قديما بالحرابة ، و هو الخروج عن القانون بقوة الميليشيا لهدف مادي أو أيديولوجي كالخوارج مثلا ، فالأصل في الفعل "أرهب" هو أثار الخوف و الخشية، و هذا ما نستخدم له اليوم لفظ الردع اصطلاحاً ، أما الإرهاب المعاصر فهو التدمير الفعلي و ارتكاب فعل القتل ، و قتل المدنيين تحديدا، و هو ما نهى الله عنه في كتابه، و نهى عنه النبي الكريم كلما عقد راية أو أطلق سرية
حتى لقد بلغت الجرأة ببعضهم أن يستخدم مطلع الآية الكريمة شعارا و تحتها السيفين! و الآية هنا يا سادة لا تتحدث عن الحرب ، و لكن عن تحقيق سلام القوة و تجنب الحرب و ويلاتها من خلال إكتساب القوة الرادعة ، و لا حديث عن الحرب ذاتها، و لا عن "الإرهاب" بمعناه الزمني اليوم ، و لكن الآية تحدثنا عن مفهوم "الردع السلمي" ، و هو الأسلوب الذي اتبعته أمريكا و الاتحاد السوفيتي مع بعضهما البعض خلال الحرب الباردة ، لأنهما حافظتا على موازين قوة ، تجعل حرب كل منهما مع الآخر مهما تفوق عليه، شيء مدمر فوق تخيل البشر، و لهذا لم تسخن الحرب الباردة ، و لن تتحرر الأرض الفلسطينية اليوم ، إلا لو امتلك العرب من أسباب القوة و مقوماتها ما يحرر الأرض بدون قتال، فعندما تمتلك القوة، تستطيع أن تجلس لمائدة المفاوضات، و غريمك يكره أن تقوم من عليها بغير اتفاق، و لكن حين تجلس في موقف الأضعف الغير واثق بقوته، فلا تكون المحصلة أكثر مما حصلناه بداية من "كامب ديفيد" و حتى اليوم ، و لم يفهم الدرس غير إيران التي تسعى حثيثا لامتلاك قوة الردع النووي ، و يوم تمتلكها ستتغير موازين القوة بالمنطقة ، و الآية تدعو المسلمين لزيادة الانفاق العسكري و عدم البخل عليه بالمال، لان الانفاق العسكري هو الحامي الحقيقي للسلام، و ذلك بقوله تعالى "وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ" و الناس لا تحتاج للتشجيع على الانفاق العسكري في غير وقت السلم، لان الضرورة في الحرب تجبرهم على ذلك، فلا الآية دعت للحرب و لا للإرهاب، و لكن لامتلاك القوة الذي يحمي السلام ، و الإرهاب فيها ليس بمعنى الإرهاب في زماننا، و لكن بمعنى الردع، و هذا معناه الحقيقي، لأن مصطلح الإرهاب المعاصر هو أمر اخترعناه للتدليل على ما كان يسمى قديما بالحرابة ، و هو الخروج عن القانون بقوة الميليشيا لهدف مادي أو أيديولوجي كالخوارج مثلا ، فالأصل في الفعل "أرهب" هو أثار الخوف و الخشية، و هذا ما نستخدم له اليوم لفظ الردع اصطلاحاً ، أما الإرهاب المعاصر فهو التدمير الفعلي و ارتكاب فعل القتل ، و قتل المدنيين تحديدا، و هو ما نهى الله عنه في كتابه، و نهى عنه النبي الكريم كلما عقد راية أو أطلق سرية و المجانين، فترى بعضهم يقول بأنه يتعين علينا أن نترك العالم في التقدم النووي و النيوتروني و نعد نحن لهم المفاجأة الكبرى، نربي الخيول و نسن السيوف، لان الحضارة ستنهار قريبا!!! و سوف يسود العالم من لديه الخيول و السيوف!!! فبماذا يرد على هذا الساذج؟ أشهد الله الحي القيوم أن بأمثاله من المهاويس تخلفت هذه الأمة و تأخرت و استقرت في قاع العالم، و بأمثاله سمينا ارهابيين ، و الارهاب ما هو الا سلاح الضعيف المقهور الموشك على الانهيار، إن المجانين الذين يسطرون الكتب عن "آرامجدون" و التي صحفت للعربية "هرمجدون" هم سر تخلفنا و خيبتنا بين العالم ، و لا أساس لأقوالهم من القرآن أو صحيح السنة في قليل أو كثير ، فآرامجدون اعتقاد كتابي تسرب للإسلام، و ليس اعتقادا إسلاميا ، فنهاية الأرض في الإسلام و القرآن ليست إلى دمار، و لكن إلى سلام شامل و ازدهار كامل، و دليل هذا في الآية الكريمة "حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" فهذه الآية تتحدث عن عهد ازدهار تزدهر فيه حضارة الإنسان، و ليست عن أرض مزروعة كما فهم البعض من لفظها المباشر، فظن البشر أنهم قادرون على الطبيعة جديد جدا و مازال في مهده بعصرنا الحديث
و المجانين، فترى بعضهم يقول بأنه يتعين علينا أن نترك العالم في التقدم النووي و النيوتروني و نعد نحن لهم المفاجأة الكبرى، نربي الخيول و نسن السيوف، لان الحضارة ستنهار قريبا!!! و سوف يسود العالم من لديه الخيول و السيوف!!! فبماذا يرد على هذا الساذج؟ أشهد الله الحي القيوم أن بأمثاله من المهاويس تخلفت هذه الأمة و تأخرت و استقرت في قاع العالم، و بأمثاله سمينا ارهابيين ، و الارهاب ما هو الا سلاح الضعيف المقهور الموشك على الانهيار، إن المجانين الذين يسطرون الكتب عن "آرامجدون" و التي صحفت للعربية "هرمجدون" هم سر تخلفنا و خيبتنا بين العالم ، و لا أساس لأقوالهم من القرآن أو صحيح السنة في قليل أو كثير ، فآرامجدون اعتقاد كتابي تسرب للإسلام، و ليس اعتقادا إسلاميا ، فنهاية الأرض في الإسلام و القرآن ليست إلى دمار، و لكن إلى سلام شامل و ازدهار كامل، و دليل هذا في الآية الكريمة "حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" فهذه الآية تتحدث عن عهد ازدهار تزدهر فيه حضارة الإنسان، و ليست عن أرض مزروعة كما فهم البعض من لفظها المباشر، فظن البشر أنهم قادرون على الطبيعة جديد جدا و مازال في مهده بعصرنا الحديثو دليلنا القطعي
 على أن الآية تتحدث عن امتلاك القوة لتوجيه دفة السلام لصالحنا، هو الآية التالية لها و فيها يقول تعالى "وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ" فهذا هو الأمر ، امتلاك القوة لردع العدو حتى يجنح للسلام، فلو جنح للسلام قبلناه منه و كنا له نميل و ننحاز، للسلام القائم على التكافؤ، لانه وحده هو السلام العادل الذي لا تقبل فيه بصفقة المغبون ، فالسلام غاية المؤمن ، على ألا يكون سلاما على حساب الشرف و الكرامة و الاستقلال و الحرية الكاملة
على أن الآية تتحدث عن امتلاك القوة لتوجيه دفة السلام لصالحنا، هو الآية التالية لها و فيها يقول تعالى "وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ" فهذا هو الأمر ، امتلاك القوة لردع العدو حتى يجنح للسلام، فلو جنح للسلام قبلناه منه و كنا له نميل و ننحاز، للسلام القائم على التكافؤ، لانه وحده هو السلام العادل الذي لا تقبل فيه بصفقة المغبون ، فالسلام غاية المؤمن ، على ألا يكون سلاما على حساب الشرف و الكرامة و الاستقلال و الحرية الكاملة هذه الآية الكريمة، يخبرنا الله تعالى بحقيقة بغاية الأهمية، تنقذنا من ضلالات كثيرة، و تؤثر في حياتنا أيما تأثير، و الحقيقة أن دنيانا هذه كانت مع بداية خلق الإنسان بدائية عنيفة و دامية، كئيبة كالأرض الخالية من الحياة ، ثم أعان الله البشر بالعديد من نعمه كما يرسل المطر على الأرض القاحلة "إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَامُ" ، و بهذه النعم، و عاما بعد عام، يتطور الإنسان و يتقدم، حتى يأتي زمان يصبح فيه العالم كله في حالة استقرار اجتماعي و وفرة في الانتاج و عدالة في التوزيع ، و يتحقق السلام العالمي، و تكون الأرض أقل مرضا و أقل فقراً و أقل شروراً، حتى يحسب الانسان أن قدرته على استقرارها قد تمت، " حتى إذَا أخَذَت الأرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أهْلُها أنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا" ثم تبقى الأرض مستقرة كهذا ما شاء الله لها الاستقرار، لثبوت نجاح تجربة الإنسان، و التي نفى الله عنها الفشل و استمرار الهمجية حين قال الملائكة بذلك، فأجابهم الرحمن أنه يعلم من امكانات هذا الكائن الجديد التي منحها اياه مالا يعلمون ، و بعد هذا يأت أمر الله بالقيامة "أتاها أمْرُنا لَيْلاً أوْ نَهاراً" فلا الإنسانية ستنحط، و لا الدنيا سترتد للقرون الوسطى كما يتوهم المتخلفون، و الذين لا زالوا يعيشون في هذه القرون بالفعل، و ياكل الحقد على البشرية كبدهم، فيقولون بردة الحضارة، فالحضارة لن ترتد أيها المرتدون، بل ستتم نهضتها بأمر ربها و إذنه
هذه الآية الكريمة، يخبرنا الله تعالى بحقيقة بغاية الأهمية، تنقذنا من ضلالات كثيرة، و تؤثر في حياتنا أيما تأثير، و الحقيقة أن دنيانا هذه كانت مع بداية خلق الإنسان بدائية عنيفة و دامية، كئيبة كالأرض الخالية من الحياة ، ثم أعان الله البشر بالعديد من نعمه كما يرسل المطر على الأرض القاحلة "إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَامُ" ، و بهذه النعم، و عاما بعد عام، يتطور الإنسان و يتقدم، حتى يأتي زمان يصبح فيه العالم كله في حالة استقرار اجتماعي و وفرة في الانتاج و عدالة في التوزيع ، و يتحقق السلام العالمي، و تكون الأرض أقل مرضا و أقل فقراً و أقل شروراً، حتى يحسب الانسان أن قدرته على استقرارها قد تمت، " حتى إذَا أخَذَت الأرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أهْلُها أنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا" ثم تبقى الأرض مستقرة كهذا ما شاء الله لها الاستقرار، لثبوت نجاح تجربة الإنسان، و التي نفى الله عنها الفشل و استمرار الهمجية حين قال الملائكة بذلك، فأجابهم الرحمن أنه يعلم من امكانات هذا الكائن الجديد التي منحها اياه مالا يعلمون ، و بعد هذا يأت أمر الله بالقيامة "أتاها أمْرُنا لَيْلاً أوْ نَهاراً" فلا الإنسانية ستنحط، و لا الدنيا سترتد للقرون الوسطى كما يتوهم المتخلفون، و الذين لا زالوا يعيشون في هذه القرون بالفعل، و ياكل الحقد على البشرية كبدهم، فيقولون بردة الحضارة، فالحضارة لن ترتد أيها المرتدون، بل ستتم نهضتها بأمر ربها و إذنه

 وم، الحروب مازالت موجودة، لكن عدد ضحاياها عالميا يقل عاما بعد عام، المرض موجود لكن البشر يتغلبون عليه و يطهرون الأرض منه مرضا بعد مرض، الفقر ما زال و لكنه في تناقص ، و ما النماذج بأعلى، من سيطرة على الجذام و القضاء عليه، و من تطور التقنية و الاتصالات، و من ارتفاع معدلات عمر البشر، الا امثلة حية ناهضة على ذلك ، فالنصر للحياة و الإنسان رغم أنف كل أعداء الحياة و الإنسان ، قد يبدو هذا الوضع مخالفا في البلاد المنكوبة بأعداء الحياة مثلنا ، و لكننا لسنا العالم يا سادة ، و ذات يوم سنخرج من ظلامنا و جهالاتنا لنور الفجر يغرد في أعيننا
وم، الحروب مازالت موجودة، لكن عدد ضحاياها عالميا يقل عاما بعد عام، المرض موجود لكن البشر يتغلبون عليه و يطهرون الأرض منه مرضا بعد مرض، الفقر ما زال و لكنه في تناقص ، و ما النماذج بأعلى، من سيطرة على الجذام و القضاء عليه، و من تطور التقنية و الاتصالات، و من ارتفاع معدلات عمر البشر، الا امثلة حية ناهضة على ذلك ، فالنصر للحياة و الإنسان رغم أنف كل أعداء الحياة و الإنسان ، قد يبدو هذا الوضع مخالفا في البلاد المنكوبة بأعداء الحياة مثلنا ، و لكننا لسنا العالم يا سادة ، و ذات يوم سنخرج من ظلامنا و جهالاتنا لنور الفجر يغرد في أعيننا
قال تعالى " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ * تُؤْتِيۤ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ" إبراهيم:24، 25، 26
 ب الآية الكريمة مثلا رائعا لكل من الكلمة الطيبة و الكلمة الخبيثة، فالكلمة الطيبة ، و إن كان المفسرون فسروها بالإيمان أو المؤمن ذاته، إلا أننا نراها أوسع من هذا نطاقا، و لا نجد كذلك داعيا من السياق و لا موضوع الآيات لتأويلها على غير معناها الظاهر، هي الكلمة الطيبة، التي تترك أثرا حسنا في نفوس من يتلقاها، قريبا كان أو بعيدا، فالطيب من الكلام و شيوعه في أي وسط او محيط، سواء كان محيطا لأسرة أو لعمل أو غير ذلك، يخلق جوا من المودة و المحبة، و يتفرع أثره في نفوس من حولنا، و أصلها الثابت هو الفضل و الحسنات التي تعطيها قائلها، و فروعها التي لا تنتهي حتى عنان السماء هي أثرها في من تلقاها من الناس، و العكس تماما في الكلمة الخبيثة، و لعلي أضرب مثلا قد يجده البعض غريبا بعض الشيء، فلو عقدنا مقارنة بين كلمات البابا السابق "جون بول الثاني" حين اعتذر عن الحروب الصليبية باسم الفاتيكان، و أقر بأنها كانت حروبا دنيئة لا تهدف لأي هدف سام، فأثلج صدور العديد من المسلمين و العرب بصفة عامة، و بين كلمات البابا "بينديكت السادس عشر" الذي حاول محاولات خائبة أن ينتقص من الإسلام، فلم يشوه الإسلام و تشوه هو، و ساءت صورته عند المسلمين و غير المسلمين، إلا من كان متطرفا و متعصبا ضد الإسلام من مهاويس الضد-إسلامية و الدمويين الذي يعشقون زراعة الفتن بين الشعوب ، فماذا لو ألزم كل منا نفسه قدر جهده بالكلمة الطيبة؟ فيصير لنا في كل قلب شجرة وارفة من الحب و التقدير، و يمتلأ قلبنا كذلك بحب الغير، أفلا تكون الحياة أفضل بتغيير ميسور هو السيطرة على اللسان و الجنان
ب الآية الكريمة مثلا رائعا لكل من الكلمة الطيبة و الكلمة الخبيثة، فالكلمة الطيبة ، و إن كان المفسرون فسروها بالإيمان أو المؤمن ذاته، إلا أننا نراها أوسع من هذا نطاقا، و لا نجد كذلك داعيا من السياق و لا موضوع الآيات لتأويلها على غير معناها الظاهر، هي الكلمة الطيبة، التي تترك أثرا حسنا في نفوس من يتلقاها، قريبا كان أو بعيدا، فالطيب من الكلام و شيوعه في أي وسط او محيط، سواء كان محيطا لأسرة أو لعمل أو غير ذلك، يخلق جوا من المودة و المحبة، و يتفرع أثره في نفوس من حولنا، و أصلها الثابت هو الفضل و الحسنات التي تعطيها قائلها، و فروعها التي لا تنتهي حتى عنان السماء هي أثرها في من تلقاها من الناس، و العكس تماما في الكلمة الخبيثة، و لعلي أضرب مثلا قد يجده البعض غريبا بعض الشيء، فلو عقدنا مقارنة بين كلمات البابا السابق "جون بول الثاني" حين اعتذر عن الحروب الصليبية باسم الفاتيكان، و أقر بأنها كانت حروبا دنيئة لا تهدف لأي هدف سام، فأثلج صدور العديد من المسلمين و العرب بصفة عامة، و بين كلمات البابا "بينديكت السادس عشر" الذي حاول محاولات خائبة أن ينتقص من الإسلام، فلم يشوه الإسلام و تشوه هو، و ساءت صورته عند المسلمين و غير المسلمين، إلا من كان متطرفا و متعصبا ضد الإسلام من مهاويس الضد-إسلامية و الدمويين الذي يعشقون زراعة الفتن بين الشعوب ، فماذا لو ألزم كل منا نفسه قدر جهده بالكلمة الطيبة؟ فيصير لنا في كل قلب شجرة وارفة من الحب و التقدير، و يمتلأ قلبنا كذلك بحب الغير، أفلا تكون الحياة أفضل بتغيير ميسور هو السيطرة على اللسان و الجنان