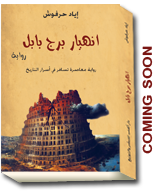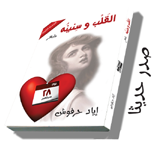للكبار فقط
لا هو وعد بلفور و لا أي وعد عليه القيمة، أتذكرون الفنانة "ملك الجمل" تلوي شفتيها و هي تلعب دور القوادة في "شفيقة و متولي" و تقول "و احنا فيه في ايدينا حاجة؟ ده كله وعد و مكتوب" ، إنه الوعد بلغة أهل الكار، و تجارة الرقيق الأبيض بلغة صفحة الحوادث، و الآداب بلغة البوليس، و البغاء في الفصحى، و المشي البطال في لغة أولاد البلد، و الدعارة في لغة المثقفين، مع تاريخ الدعارة نلتقي اليوم، نعم ، فلقاع المدينة أيضاً تاريخه، و للجواري أيضاً تراثهن الممزوج برائحة العرق و الخمر الرديئة و البنكنوت، و قاع المدينة هذا دائما ما يروي حدوتة الوجه الآخر، ذلك الذي لا نحب أن نراه فينا، و لا نحب أن نعترف به في إطار الإزدواجية العتيدة، لكن هذا لا ينفي وجوده، و لا ينفي أن التاريخ كما يحفظ سيرة العظماء و النبلاء، يحفظ شذرات من تاريخ ملح الأرض، الناس العاديين و ما تحت العاديين، و هذا جانب مثير للبحث، و لعل من أجود الأبحاث فيه ما قام به الدكتور "عبدالوهاب بكر" في بحثه الشيق بعنوان "مجتمع القاهرة السري من عام 1900م الى 1951م" و هو بحث تاريخي قيم أتاح للدكتور و رجل الشرطة السابق النفاذ لأعماق هذا المجتمع المنبوذ ، من خلال وثائق حكومية بوليسية غير منشورة ، و من هنا أهميته، غير أني أردت أن أصحبكم في جولة أقدم من تاريخ البحث قبل النفاذ إلى موضوعه، لأننا نحن أبناء الطبقة الوسطى المصرية، من نلعب دور المضحوك عليهم دائما في حركة التاريخ، حيث تربينا على مثل لا تتمسك بها سوى هذه الطبقة ، أو بعض منها لو أردنا الدقة، و قدمت لنا هذه المنظومة على أنها السائدة في بلادنا، و لقمنا منذ الطفولة الحشيشة المخدرة التي محتواها أن الغرب له العلم و التقدم و نحن لنا الأخلاق ، فتعالوا بنا ننظر لقاع مدننا و بلادنا عبر التاريخ، لنعرف أن مجتمع الفضيلة لم يوجد بعد على سطح الأرض، و لن يوجد
و لا أي وعد عليه القيمة، أتذكرون الفنانة "ملك الجمل" تلوي شفتيها و هي تلعب دور القوادة في "شفيقة و متولي" و تقول "و احنا فيه في ايدينا حاجة؟ ده كله وعد و مكتوب" ، إنه الوعد بلغة أهل الكار، و تجارة الرقيق الأبيض بلغة صفحة الحوادث، و الآداب بلغة البوليس، و البغاء في الفصحى، و المشي البطال في لغة أولاد البلد، و الدعارة في لغة المثقفين، مع تاريخ الدعارة نلتقي اليوم، نعم ، فلقاع المدينة أيضاً تاريخه، و للجواري أيضاً تراثهن الممزوج برائحة العرق و الخمر الرديئة و البنكنوت، و قاع المدينة هذا دائما ما يروي حدوتة الوجه الآخر، ذلك الذي لا نحب أن نراه فينا، و لا نحب أن نعترف به في إطار الإزدواجية العتيدة، لكن هذا لا ينفي وجوده، و لا ينفي أن التاريخ كما يحفظ سيرة العظماء و النبلاء، يحفظ شذرات من تاريخ ملح الأرض، الناس العاديين و ما تحت العاديين، و هذا جانب مثير للبحث، و لعل من أجود الأبحاث فيه ما قام به الدكتور "عبدالوهاب بكر" في بحثه الشيق بعنوان "مجتمع القاهرة السري من عام 1900م الى 1951م" و هو بحث تاريخي قيم أتاح للدكتور و رجل الشرطة السابق النفاذ لأعماق هذا المجتمع المنبوذ ، من خلال وثائق حكومية بوليسية غير منشورة ، و من هنا أهميته، غير أني أردت أن أصحبكم في جولة أقدم من تاريخ البحث قبل النفاذ إلى موضوعه، لأننا نحن أبناء الطبقة الوسطى المصرية، من نلعب دور المضحوك عليهم دائما في حركة التاريخ، حيث تربينا على مثل لا تتمسك بها سوى هذه الطبقة ، أو بعض منها لو أردنا الدقة، و قدمت لنا هذه المنظومة على أنها السائدة في بلادنا، و لقمنا منذ الطفولة الحشيشة المخدرة التي محتواها أن الغرب له العلم و التقدم و نحن لنا الأخلاق ، فتعالوا بنا ننظر لقاع مدننا و بلادنا عبر التاريخ، لنعرف أن مجتمع الفضيلة لم يوجد بعد على سطح الأرض، و لن يوجد
ما أقوله هنا هو رؤية و تأملات خاصة لا أنسبها لأي مرجع آخر، لكنني أجد التاريخ يقول لنا أنه في المجتمعات الأمومية التي كان للمرأة فيها سيادة اقتصادية و بالتالي اجتماعية على الرجل، و جدت و انتشرت الدعارة الرجالي، للترفيه عن الأنثى المتعبة و المكدودة، الشقيانة بالبلدي، و يبدو أن إناث هذا الزمن وجدن من التبريرات مثل ما يجده الرجال اليوم لسلوكهن هذا، فكن يقلن أن رجل واحد لا يكفي و أن المرأة بطبيعتها تميل للتعدد، و من أمثلة هذه المجتمعات الأمية ، كما تقول بعض النظريات، مجتمعات مثل اليونان ما قبل 7000 قبل الميلاد، أي ما قبل العصر البرونزي، و نحن نقبل هذه النظرية لأنها بداية طبيعية للمجتمعات البشرية نظرا لتسود هذه الطبيعة في مجتمعات الحيوان و الطيور، و لكن بالنسبة لذكر الإنسان، فقد أعانه اختراعه للآلات و السلاح على السيادة الاقتصادية مبكرا في التاريخ، و بالتالي التسود الاجتماعي ، فحلت دعارة الإناث محل دعارة الرجال، و هذا للترفيه عن السيد صاحب رأس المال، الذي ادعى كما ادعت النساء سابقا، و في العصر الحديث، بعد أن استعادت المرأة بعضا من سيادتها و امتلكت النساء رأس المال ثانية، عادت الدعارة المذكرة للظهور، من إيطاليا لمصر لأسبانيا لجنوب أفريقيا، في صورة الجيجولو التقليدي صديق النسوة العجائز ، و لهؤلاء الآن مقاهي خاصة في كل من مارينا و شرم الشيخ
الدعارة المقدسة في مصر القديمة
المقدسة في مصر القديمة
لم يكن الجنس عند الفراعنة أحد التابوهات الإجتماعية كما هو اليوم، فقد آمن المصري القديم بوجود الجنس حتى في الحياة الأخرى، كما وجد اعتقاد مشابه للاعتقاد الهندوسي في التطهر بالجنس للوصول لحالة الصفاء الروحي ، و قد عرفت مصر القديمة الدعارة المقدسة كالعديد من الشعوب القديمة، و عندما نقول دعارة في هذه الحقبة، يجب أن ننفي من عقولنا الصور التي نتخيلها دوما من واقعنا المعاصر لهذه السيدة المتهتكة الهلوك ، فنحن الآن أمام سيدة محترمة جدا في زمانها، و قريبة الصلة بالعديد من الآلهة، على رأسهم "بس" رب المرح و الترفيه، و "هاتور" ربة الجمال و الحب ، و كما يقول موقع علم المصريات بجامعة آيوا، كان الزي الرسمي للدعارة وقتها هو فستان من نسيج أشبه بشباك الصيادين (الصورة من متحف بيتري) مع وضع أحمر الشفاه الثقيل و الكحل المرسوم بعناية، و كانت من ضمن مهام عاهرات المعبد هاتيك ، تدريب الشباب المقبل على الزواج و الفتيات على الجنس بأسلوب "بيان على المعلم" و كن يحرصن كذلك كما تضيف مصادر جامعة تورنتو ، على دق الوشم في أماكن كالصدر و الفخذين ، خاصة وشم الإله بس ، و بينما يعرف الكثيرون عن آثار كواجيهيرو الهندية المليئة بالأيقونات الجنسية، نجد القليل فقط من المصريين من يعرف شيئا عن" بردية التورين" التي صورت الأوضاع الجنسية المختلفة في شكل احتفالي إلى حد كبير ، كذلك بردية لإمرأة ترتدي التاج الملكي و يرجح أنها حتشبسوت في لقاء جنسي مع رجل ، و كما قلنا لم تكن مصر وحيدة في هذا و لكن مثلها مثل بابل و الهند و اليونان القديمة و غيرها
الرايات الحمر في قريش
لطالما ارتبطت الدعارة المؤنثة بالأديان الوثنية القديمة، و لم تكن مكة في الجاهلية استثناء من هذا الأمر، بل كانت أحد المجتمعات التي عرفت الدعارة المقدسة ، و لم يكن العرب يعتبرون ممارسة الجنس مع عاهرة زنا، لكن الزنا ما كان مع زوجة رجل آخر أو امرأة حرة عامة، لما يترتب عليه من إحساس بالعار لدى قبيلة معينة، نظرا للإعتداء على ممتلكاتها ، باعتبار النساء من ضمن هذه الممتلكات، و قد كره العرب هذا اللون من الزنا لأنه يجر عليهم الحرب و الدماء، أما المحترفات فكن يعتبرن كجواري من لا جواري له، و كلنا يعرف تعبير صاحبات الرايات الحمر في مكة ، و التي ألغاها الإسلام مع فتح مكة، و بسبب هذا التفريق بين الزنا مع الحرة و بين وطء صاحبات الرايات الحمر ، جاء تحريم الدعارة و التشجيع عليها في القرآن مستقلا و منوهاً عنه برغم التحريم العام للزنا من قبله، بينما نجد في الكتاب المقدس سيرة لمضاجعة واحدة ظنها الشيخ فتاة من فتيات الدعارة حول المعبد بدون الإشارة إلى تحريم و لا تجريم، و الطريف في أمر فتيات مكة هؤلاء، أن بعضهن كن جوارِ مملوكات لسادة قريش الذين يتبارون على الشرف و الوجاهة ، و يعملن لصالح هؤلاء السادة، و يأتي في مقدمتهم حرب بن أمية و من قبله والده أمية بن خلف، و كانت واحدة من جواري حرب تعمل بالدعارة في الموسم ثم تعود لكنف حرب بن أمية باقي العام، و قد ولدت له فأنجبت، ولدت "أبا سفيان بن حرب" سيد قريش و سيد المحاربين لدعوة الشرف و النور حين بعثها الله على نبيه ، و لكن لم يكن أبو سفيان يستشعر العار من هذا كثيرا، ففي الجاهلية كان العرب بينهم بيوت شرف كهاشم، و بينهم بيوت لها المال دون الشرف كأمية، فلم يكن أبو سفيان وحيداً في هذا العار، و لا كان إنجابه للمدعو "زياد بن أبيه" بنفس الطريقة مستغربا عليه، و زياد هذا هو من وعده "معاوية" بعد ذلك بنسبه لأبيه و رفع العار عنه ، لو أعانه زياد على خصومه، فصار زيادا ابن أبي سفيان
دعارة القرنين الثامن و التاسع عشر
كان لكل منطقة من مناطق القاهرة وقتها ما يسمى "شيخ العرصة" و منه يشتق اللفظ العامي المعبر عن الديوث، و هو عبارة عن وظيفة إدارية مثل شيخ الحارة، لكن منطقته أوسع و مهنته أحقر كثيرا، فكانت مهنته تنسيق علاقات العاهرات بالدولة السنية، و التي كانت لم تشرع العهر بعد، لكن لم يمنعها ذلك من جمع الضرائب من العاهرات و المندارين، و عندما جاء إلى مصر "عبد الله بونابرته" الشهير بنابليون بونابرت، و كان قد ادعى لنفسه هذا الاسم لما علم ان المصريون "منط" و لا يشترطون لحكمهم إلا أن يكون الرجل مسلماً، فادعي الإسلام و تسمى باسم إسلامي (ناقصين بلاوي احنا؟) و قد أنشأ في عهد سيادته الرشيد "كارخانة" لعسكر الفرنسيس ، و ألحق بها الراقصات و العاهرات، و كانت تعرف باسم "غيط النوبي" لأن شيخ العرصة بها كان نوبياً، و حين تولى "محمد علي" باشا سمح بالدعارة لفترة، لأن الكثيرين من "أولاد الناس" ، و هو اللقب الذي كان يطلق على المماليك و أولادهم، كانوا يستثمرون في شراء الجواري لتشغيلهن في الدعارة، فلما قضى على المماليك، نفى العاهرات لمدينتي إسنا و الأقصر و قنا في الصعيد، و الذي لم يكن محمد علي يهتم به بصفة عامة، و لكن حين تولى عباس الأول، سمح دولته بعودة رعاياه من البغايا للقاهرة الساهرة العامرة
في القرنين التاسع عشر و العشرين، كانت حركة الثقافة في مصر على أشدها، فقد أفاق الواعون من أبناء البلد يحاولون أن يصلوه بالعصر الحديث و آدابه و علومه، و بينما كان هؤلاء المساكين من المتطلعين نحو العلا يلهجون الأنفاس طلبا للعلم و النور، و كفاحا من أجل الاستقلال و بناء اقتصاد وطني و غيرها من ساميات الأهداف، كعادة أبناء الطبقة المتوسطة المصرية، في ذلك الوقت، كان قاع المجتمع يفور بأحداثه الخاصة، حيث مثل جنود الاحتلال الانجليزي سوقا مستهدفا ضخما للعاهرات، و أرجو أن ننفي من رؤوسنا صورة البغي الشريفة (زي مادلين طبر في الطريق إلى إيلات كده) و التي كانت تمارس البغاء مع الانجليز لهدف قومي، فصاحبات الإنجليز هاتيك كن أخلص للجنيه منهن لآبائهن فضلا عن الوطن، على هذا تربين، فنشأن بنات مخلصات لبيئتهن الأم
لقد عرفت مصر المحروسة الدعارة المشروعة و المرخص بها قانونا من عام 1900 و حتى عام 1949 حين صدر قانون بمنعها، و في خلال هذه الفترة، صدر عام 1905 م ما يسمى بلائحة تنظيم بيوت العاهرات، و بعدها لائحة البيوت العمومية عام 1916م كما يورد الدكتور عبد الوهاب في مرجعه القيم، و يروي كذلك أن الانجليز اهتموا بالعاهرات كثيرا للحفاظ على صحة جنودهم، فكان مندوبو السرية الطبية البريطانية يجلسون أمام الطوابق الأرضية للمواخير حيث يسلمون كل جندي واقيا ذكريا وعلبة مرهم وكراسة بالتعليمات!!! نعم كراسة التعليمات مش هزار
و كان للوعد ساحاته و ميادينه، فكانت مناطق مثل كلوت بك، الوسعة، وش البركة، و درب طياب (جاء ذكره في فيلم درب الهوى) و عطفة جندف، درب المصطفي في القاهرة، و كانت منطقة ما وراء الحقانية و جبل نعسة و بعض حارات المنشية فضلا عن حي اللبان هي مناطق الدعارة ، اما في باقي المحافظات فكان منها سوق اللبن في المحلة الكبرى، كفر القرشي في طنطا، الخبيزة في الاسماعيلية و شبين الكوم و غيرها كثير، أما عن السعر، فكانت أرخص المواقع تقع في منطقة "عرب المحمدي" و يصف الدكتور عبد الوهاب في كتابه قائلا "وكانت 'محلات الممارسة فيه لاتتجاوز حفرة في الأرض ممهدة للقاء وتغطي من أعلي بستارة تثبت ببعض الحجارة من أطرافها بواسطة القواد أو القوادة' وعندما يفرغ العميل من مهمته يتم رفع الحجارة وازالة الستارة لدخول عميل جديد! أما منطقة الأزبكية طبقا لتقرير بوليس مدينة القاهرة عام 1893 فقد كانت تضم أعلي نسبة من الفنادق والغرف المفروشة، بينما كانت منطقة الوسعة ووش البركة في الأزبكية تضم عشرات البيوت المقسمة لغرف أو حتي دكاكين مغطاة بستائر، وسعر الممارسة كان يتراوح في العشرينات بين شلن و 15 قرشا مكتوب علي الباب، كما كانت هناك بيوت أخري مغطاة بقضبان حديدية تجلس خلفها المومسات بوجوههن المصبوغة. وعندما صدر الأمر العسكري عام 1942 باغلاق منطقة وش البركة لجأت العواهر في ممارسة
و ميادينه، فكانت مناطق مثل كلوت بك، الوسعة، وش البركة، و درب طياب (جاء ذكره في فيلم درب الهوى) و عطفة جندف، درب المصطفي في القاهرة، و كانت منطقة ما وراء الحقانية و جبل نعسة و بعض حارات المنشية فضلا عن حي اللبان هي مناطق الدعارة ، اما في باقي المحافظات فكان منها سوق اللبن في المحلة الكبرى، كفر القرشي في طنطا، الخبيزة في الاسماعيلية و شبين الكوم و غيرها كثير، أما عن السعر، فكانت أرخص المواقع تقع في منطقة "عرب المحمدي" و يصف الدكتور عبد الوهاب في كتابه قائلا "وكانت 'محلات الممارسة فيه لاتتجاوز حفرة في الأرض ممهدة للقاء وتغطي من أعلي بستارة تثبت ببعض الحجارة من أطرافها بواسطة القواد أو القوادة' وعندما يفرغ العميل من مهمته يتم رفع الحجارة وازالة الستارة لدخول عميل جديد! أما منطقة الأزبكية طبقا لتقرير بوليس مدينة القاهرة عام 1893 فقد كانت تضم أعلي نسبة من الفنادق والغرف المفروشة، بينما كانت منطقة الوسعة ووش البركة في الأزبكية تضم عشرات البيوت المقسمة لغرف أو حتي دكاكين مغطاة بستائر، وسعر الممارسة كان يتراوح في العشرينات بين شلن و 15 قرشا مكتوب علي الباب، كما كانت هناك بيوت أخري مغطاة بقضبان حديدية تجلس خلفها المومسات بوجوههن المصبوغة. وعندما صدر الأمر العسكري عام 1942 باغلاق منطقة وش البركة لجأت العواهر في ممارسة ، نشاطهن مع جنود الاحتلال إلي المقاعد الخلفية في عربات الحنطور، أما نظام المحاسبة فكان اكثر إثارة للتقزز والبشاعة، ففي منطقة عرب المحمدي كان اللقاء الجنسي يتم في حفر نعم مجرد حفر مجهزة في التلال. وكان العميل يدفع أولا للقواد، وفي نهاية اليوم وحتي تحصل المومس علي اجرها كانت تقدم للقواد حصيلة انتاجها وهي كيزان ممتلئة بالسائل المنوي للعملاء الذين افرغوا في جهازها التناسلي ويدفع القواد مبلغا محددا لقاء كل كوز.. لا أظن أن هناك أكثر بشاعة أو إثارة للتقزز من هذا الامتهان الفظيع" و على ذكر الحنطور، ألم تتساءل أبدا ما هو أساس موضوع "علي عوض" هذا و لماذا يضايق اسمه العربجية؟ خاصة اذا ذكر مقترنا بكرباج ورا يا أسطى؟ فاتت هذه النقطة أستاذنا الدكتور عبد الوهاب في بحثه الشائق، و المروي بخصوصها أن علي عوض، و هذا كلام سمعته أنا من عربجي و العهدة عليه، كان أحد شيوخ العربجية، و كان مشهورا بالتنسيق بين العاهرات و العربجية و قبض عمولة على عملية السمسرة هذه، فعير به العربجية
، نشاطهن مع جنود الاحتلال إلي المقاعد الخلفية في عربات الحنطور، أما نظام المحاسبة فكان اكثر إثارة للتقزز والبشاعة، ففي منطقة عرب المحمدي كان اللقاء الجنسي يتم في حفر نعم مجرد حفر مجهزة في التلال. وكان العميل يدفع أولا للقواد، وفي نهاية اليوم وحتي تحصل المومس علي اجرها كانت تقدم للقواد حصيلة انتاجها وهي كيزان ممتلئة بالسائل المنوي للعملاء الذين افرغوا في جهازها التناسلي ويدفع القواد مبلغا محددا لقاء كل كوز.. لا أظن أن هناك أكثر بشاعة أو إثارة للتقزز من هذا الامتهان الفظيع" و على ذكر الحنطور، ألم تتساءل أبدا ما هو أساس موضوع "علي عوض" هذا و لماذا يضايق اسمه العربجية؟ خاصة اذا ذكر مقترنا بكرباج ورا يا أسطى؟ فاتت هذه النقطة أستاذنا الدكتور عبد الوهاب في بحثه الشائق، و المروي بخصوصها أن علي عوض، و هذا كلام سمعته أنا من عربجي و العهدة عليه، كان أحد شيوخ العربجية، و كان مشهورا بالتنسيق بين العاهرات و العربجية و قبض عمولة على عملية السمسرة هذه، فعير به العربجية
مصطلحات وعدية عريقة
كما لكل مهنة مصطلحاتها، و تخصصاتها، كذلك كان الحال عندما ازدهرت أقدم مهنة في التاريخ في مصر المحروسة، فكانت هناك تخصصات و أدوار موزعة بدقة، و عمل يمتاز بروح الفريق العالية جدا في خدمة ... في خدمة الشباب و طلاب العلم و المعلمين و الفلاحين و الأفنديات من رواد اوكار الدعارة أو جالبي الداعرات، فكانت هناك الاختصاصات التالية
- المومس: و هذه معروفة للجميع، فهي لب الموضوع و السلعة التي تباع للمستهلك النهائي
- المندار / الخنت: و يعني في مصر قديما الشاذ المخنث، و كانت الفحوص الطبية التي تجرى للكشف عليه تسجل نتيجتها بكليشيه رسمي يكتب فيه "مستعمل من الخلف و يهوى كما تهوى النساء" و مازالت فيم أظن تكتب في اختبارات الجيش حتى الآن، و يعفى من كان كذلك من التجنيد
- البادرونة: و هن صاحبات البيوت الحاصلة على رخصة الدعارة ، و هي مأخوذة من "باتروناج" الفرنسية أو "باترونة" الايطالية
- السحاب و السحابة: و هو الموكل باستلقاط البنات المرشحات للعمل و اقناعهن بالعمل في الدعارة
- القواد: المكلف بفرز الناس في الشوارع المحيطة و اختيار الزبون (المليان) ليكون من نصيب فريقه
- العايقة: و هي العاهرة بعد الخمسين و التي لا يرخص لها بممارسة الدعارة بعدها، و غابا ما تعمل سحابة أو قوادة حسب مهاراتها
- البرمجي: لا مش مفرد برمجيات، ده بضم الباء، و هو عشيق المومس و الحارس الخاص لها، فهو بلطجي متخصص أو حارس شخصي، و كان على كل مومس أن تملأ عين البرمجي الخاص بها و تطعمه و تجلب له الدخان و الكيوف، و الا هجرها الى غيرها، فاذا كان خلفه ضعيفا، أصبحت هي و هو هفية في حي البغاء
- البلطجي: و هذا لا دور له لكنه يفرض اتاوة على المومسات و البرمجية، بقهر عصابته، و قد بدأ هؤلاء أتراكا، و أصل الكلمة من
 فرقة البلطجية بالجيش العثمانلي، و كان دورها تقطيع الغابات لمرور الجيش التركي في غزو أوروبا، فكانوا ضخام الجثث يجيدون الضرب بالبلطة و لا يجيدون فنون القتال، و حين أصبحت تركيا الرجل المريض، سرح هؤلاء فانتشروا بين مصر و الشام يرتزقون بالبلطة و الارهاب بها
فرقة البلطجية بالجيش العثمانلي، و كان دورها تقطيع الغابات لمرور الجيش التركي في غزو أوروبا، فكانوا ضخام الجثث يجيدون الضرب بالبلطة و لا يجيدون فنون القتال، و حين أصبحت تركيا الرجل المريض، سرح هؤلاء فانتشروا بين مصر و الشام يرتزقون بالبلطة و الارهاب بها
زمن القمة: الصيني نزل المهندسين
نستطيع بكل الفخر و الكبرياء أن نقول أن مصر تشهد أزهى عصور الوعد، فبعد "وعد" الرئيس المؤمن رحمه الله لنا بالرخاء و الرفاهية، حقق وعده و انفتحنا على الآخر، و طغت سيرة شارع الهرم على الهرم ذاته في بلاد الغترة و الشماغ ، و بعده لم نتوقف أبداً، بل استمرت المسيرة في العلو و الصعود لمكان الصدارة الوعدية، فهذه هي المهندسين قد غدت اليوم أحد أسخن بقاع الدعارة على مستوى القارة ربما، فتصبح شوارعها مساء في الصيف لا تطاق من كثرة الأشمغة و إماء الدولار و الدرهم و الريال، و الغريب أن هناك شتائم خاصة بين العاهرات و بعضهن، فتقول واحدة لأخرى "يا بتاعة العرب" مشيرة لممارستها مع السواح من الأشقاء العرب، طيب هو فيه منهم بينقي يعني؟ آه فيه، يقول من يدعي العلم ببواطن الأمور أن هناك متخصصات في الأجانب و هؤلاء يقطن منطقة المعادي و الزمالك و غيرها، و يرافقن الزبون مدة وجوده أو جزء منها بمقابل راتب يومي أو شهري ثابت، منها دليل و منها كل حاجة، و منهن بتوع العرب، و هؤلاء بالليلة او الأسبوع، أما أحط الأنواع فيقال لها "بتاعة الطلبة" و هذه عادة ما تكون في النزع
الفخر و الكبرياء أن نقول أن مصر تشهد أزهى عصور الوعد، فبعد "وعد" الرئيس المؤمن رحمه الله لنا بالرخاء و الرفاهية، حقق وعده و انفتحنا على الآخر، و طغت سيرة شارع الهرم على الهرم ذاته في بلاد الغترة و الشماغ ، و بعده لم نتوقف أبداً، بل استمرت المسيرة في العلو و الصعود لمكان الصدارة الوعدية، فهذه هي المهندسين قد غدت اليوم أحد أسخن بقاع الدعارة على مستوى القارة ربما، فتصبح شوارعها مساء في الصيف لا تطاق من كثرة الأشمغة و إماء الدولار و الدرهم و الريال، و الغريب أن هناك شتائم خاصة بين العاهرات و بعضهن، فتقول واحدة لأخرى "يا بتاعة العرب" مشيرة لممارستها مع السواح من الأشقاء العرب، طيب هو فيه منهم بينقي يعني؟ آه فيه، يقول من يدعي العلم ببواطن الأمور أن هناك متخصصات في الأجانب و هؤلاء يقطن منطقة المعادي و الزمالك و غيرها، و يرافقن الزبون مدة وجوده أو جزء منها بمقابل راتب يومي أو شهري ثابت، منها دليل و منها كل حاجة، و منهن بتوع العرب، و هؤلاء بالليلة او الأسبوع، أما أحط الأنواع فيقال لها "بتاعة الطلبة" و هذه عادة ما تكون في النزع الخير من عمر أنوثتها، و زهيدة السعر، فيكنى عن هذا بانها في متناول الطلبة
الخير من عمر أنوثتها، و زهيدة السعر، فيكنى عن هذا بانها في متناول الطلبة
المصيبة الجديدة بقى، الصين دخلت معانا ع الخط يا رجالة، الغزو الصيني بعد أن احتل مرافق و أسواق البلد في كل شيء، جاب من الآخر و بعت لنا الكتاكيت بتوعه، و يقال أن الظاهرة على مستوى اقليمي شرق-أوسطي تعاني منها لبنان و مصر و الإمارات العربية و المغرب، و هن بالطبع يحطمن الأسعار تحطيما، فضلا عن شبابهن و رشاقتهن الغير متوفرة في الصنف المحلي، و بدأ الأشقاء ريقهم يجري على الصيني بعد غسيله، و يبدو ان البساط بدأ يسحب من تحت يد المنظومة المصرية الحالية من السحابين و القوادين و المومسات، و هذا العنصر الوافد يعمل بطريقة البيع المباشر للجمهور بدون وسطاء و لا سحابين و لا غيره، لهذا فالمنافسة السعرية ساحقة، المشكلة ليست في الصين و من جاء منها و حسب، لكن المأساة في المنافسة المحلية من الهواة، فكلنا سمعنا عن شبكة دعارة العذارى قريبا في الصحف و المواقع، ده فضلا عن وجود بعض السائحات من دول الغترة و الشماغ أيضاً يردون القلم و يمارسون اللعبة مجانا مع الشباب المصري و غيره هنا في ذات الأماكن التي يعبث بها رجالهن! فهل هذه هي السياحة التي نحرص عليها و لدينا كل ألوان السياحة الدينية و الثقافية و العلاجية؟
العذارى قريبا في الصحف و المواقع، ده فضلا عن وجود بعض السائحات من دول الغترة و الشماغ أيضاً يردون القلم و يمارسون اللعبة مجانا مع الشباب المصري و غيره هنا في ذات الأماكن التي يعبث بها رجالهن! فهل هذه هي السياحة التي نحرص عليها و لدينا كل ألوان السياحة الدينية و الثقافية و العلاجية؟